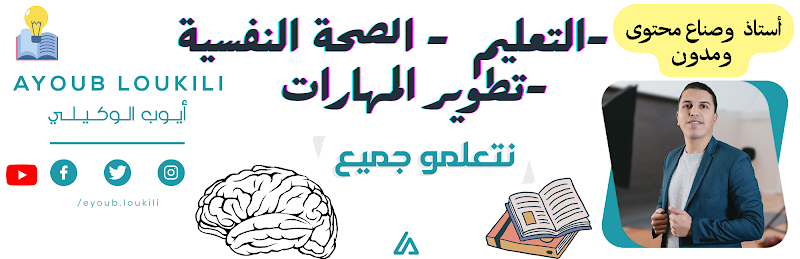· موقع المفهوم في النص الفلسفي:
يمكن القول أن
التفلسف ليس مجرد اكتفاء بتحصيل مضامين معرفية، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك مجال
للحديث عن عملية التفكير دون مضمون معرفي تستند إليه تلك العمليات، ولذلك فإن
التركيز على المفهوم كحجر الزاوية في الدرس الفلسفي يحتاج منا أن نعود إلى النصوص
الفلسفية، وبناء على ذلك فإن الكشف عن
شبكة المفاهيم عملية أساسية لتمثل الموضوعة وقضايا النص، خاصة و أن المفاهيم في
النص هي بمثابة المفتاح التي بواسطتها يلج المتعلم إلى أفكار الفيلسوف و مقاصده.
كما أن هذا الكشف عن المفاهيم يجعل المتعلم
بمنأى عن ذلك التسيب المفهومي الذي يوقعه في الكلام الفارغ، أو العبارات الخالية
من أي معنى، و يحميه من التعامل مع المفهوم كمجرد كلمة لا قيمة لها. "لأن
النص يكون كلا عضويا، فإنه يستعمل مفاهیم، لا يمكن على الإطلاق ضبط دلالتها بشكل
معزول، إذ أن كل مفهوم لا يمكن فهمه إلا في علاقته مع المفاهيم الأخرى، و في نفس
الوقت يساهم في تعريفها"[1]،
إذا تساهم هذه الطريقة في تفجير معاني النص من الداخل شريطة أن ينتبه المتعلم إلى
العلاقات الموجودة بين المفاهيم داخل النص، حتى يتبين دلالتها ومعناها حسب سياق، و من ثم يستطيع المتعلم إدراك و
استيعاب المفهوم في علاقته مع مفاهيم أخرى، لأن القول الفلسفي هو عملية نحث
للمفاهيم.
إذن
فإن الاشتغال على مفاهيم النص يتطلب منا، أن ننطلق من
"مفهمة النص الذي نقرأه انطلاقا من الكلمات، بحيث نقوم بتميز الفكرة المحددة
بدقة أي المفاهيم مع تجديد شبكة
العلاقات بين هذه المفاهيم. إن هذا المظهر الأصيل للفكر(الموضوعات
والعلاقات) هو الذي يشكل
في تماسكه، ولكن أيضا في لا تفكيره، التصور الذي يعرضه النص"[2]
، بهذا المعنى فإن رصد شبكت المفاهيم داخل النص وتتبع تطورها ونوعية العلاقات
والروابط التي تحدد الرؤية العامة للنص تعد نقطة مهمة في تحليل النص.
وعليه
فإن مرحلة المفهمة تلعب دورا أساسيا في
تحليل النص الذي يمكن المتعلم من القدرات
الفكرية التي تسمح له باستخراج دلالات المفاهيم عبر شبكة العلاقات التي تقيدها
بمفاهيم أخرى تتحدد معانيها بالتبادل، و كذلك تمكن التلاميذ من القدرات التحليلية لتمكينهم من توظيف هذه
المفاهيم بطريقة سليمة في الكتابة الإنشائية.
مع إبراز القيمة الفلسفية التي تحتلها
"المفاهيم" في النصوص الفلسفية، لأن المقاربة المفاهيمية بعيدة عن شرح
المفاهيم وتفسيرها بالاكتفاء بالمعطيات القاموسية، فهي لا تعطي سوى إمكانية قديمة
للاستعمال المفهوم." و من هنا تأتي أهمية الانتباه المتيقظ جدا للقارئ، اتجاه
المعجم و العلاقات سیمانطقية، فكما أن لكل
كلمة معنى ما في لسان ما - كما بين ذلك دي سوسير De Saussure- أي معنى محدد من
خلال معاني الكلمات الأخرى في اللسان، فكذلك كل تعريف للمفهوم هو عبارة عن نفي له. فأن نقول ما هو هذا المفهوم يعني أن نقول ما ليس هو"[3].
المفهوم وليد نسق فلسفي:
لأن كل مفهوم يحمل تراثا فلسفيا ساهمت فيه أنساق
فلسفية عديدة، إذا حينما يدخل في علاقات إشكالية مع مفاهيم أخرى يولد حركية بين
مختلف الدلالات التي يحملها إذ أن "تاريخ الفلسفة لن يبقى تاريخ المفاهيم،
إنه قراءة لتاريخ حكاياتها كيف تولد و توجد وتزول، و حين نقول أن تاريخ الفلسفة،
فليس تقدمه بالمفاهيم بل تنمو قدرته على خلق المفاهيم"[4]
وبذلك يمكن القول أن تطور ونمو الفلسفة عبر تاريخها الطويل، تحقق عن طريق تشكيل
المفاهيم، وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر
دلالة المفهوم كما يراها الباحث في مجال الديداكتيك مشيل طوزي، حيث يقول:
"يحيل على فكرة واحدة أو أكثر (...) وتنفتح على العديد من التصورات الفلسفية،
لذا فتحديد خاصيتها رهين بحقل مذهبي محدد"[5]
ومن
هذا المنطلق فإننا في حاجة للاحتفاظ لكل فيلسوف بمفاهيمه الخاصة، و بعبارة أخرى لا
ينبغي نقل مفهوم من حقل فلسفي إلى آخر أو عزله عن محيطه، و بذلك فإن المفاهيم
الفلسفية لا تحمل نفس المعنى في كل الحقول و الأنساق الفلسفية، حيث يرتحل المفهوم
من نسق فلسفي إلى آخر، وعليه فإن كل فيلسوف يبدع عدته المفاهيمية بكل مستقل، فالجوهر مثلا عند أرسطو ليس هو الجوهر عند
كانط، والعلة عند أرسطو ليست هي العلة عند ليبنيز، و مفهوم الميتافيزيقا عند كانط ليس
كما يتصوره نيتشه.... إلخ.
إذن فمن خلال "المفهمة باعتبارها سيرورة
للتفكير، هي المسعى الذي ننتقل من خلاله من الموضوعة إلى البناء الذهني للمفهوم"[6].
و من هنا يمكن القول أن المفاهيم الفلسفية تحمل مقاصد معينة، تتحول و تتغير
معانيها و دلالاتها بتغير هذه المقاصد واختلافها.
اختلاف دلالات المفهوم حسب السياق المعرفي:
كما أن هذه المفاهيم تشغل وظائف مختلفة من نسق معرفي إلى نسق معرفي آخر،
فمفهوم "القانون" مثلا كما يقول ميشال طوزي: "لا يحمل نفس المعني
داخل ميادين القضاء، أو الأخلاق، أو الأبستمولوجيا، أو الاستطيقا... لكن البحث عن
إشكالية الوحدة الدلالية التي تخترق الحقول التطبيقية تكشف في العمق عن مفهوم
الموضوعة (مثلا: اعتبار القانون كنظام مهما كان نوع الحقل التطبيقي)"[7]
بناء على ما سبق ليس هناك أي مفهوم معطی بل يتم بناؤه و تشكيله في سياق بناء تصور فلسفي معين، بعيدا عن كل البداهات المضللة و المباشر المغلوطة، و ذلك للكشف عن البنيات الداخلية للموضوعة أي القضية الفلسفية التي نعمل على فتح النقاش حولها. فالنظرية الفلسفية لا يوجدها الفيلسوف لخدمة المفاهيم، بل إن لكل مفهوم داخل نظرية ما وظيفة وموقع، و ليس له من دلالة مخصوصة إلا في نطاق تلك الوظيفة، و إذا غيرنا فيهما تغيرت دلالة المفهوم.
موقع المفهوم في الدرس الفلسفي:
بهذا المعنى فإن المفهوم
يلعب دورا كبيرا في بناء الدرس الفلسفي، بل إن القيمة التي يحتلها المفهوم في هذا الدرس.
إذا أمكن أن نقول - أشبه بالقيمة التي يحتلها الفرض داخل النسق العلمي، لأن فهم
التلميذ للنص الفلسفي رهين بامتلاكه لمفاهيم هذا النص، و كيفية التميز بين
المفاهيم المحورية والمفاهيم الفرعية، و بين المفاهيم في سياقها الفلسفي والمفاهيم
في سياقها العلمي أو الفني أو الأدبي، وهذه العملية إذا تمت سيكون المتعلم قادرا
على توظيفها، إما في الإنشاء الفلسفي أو في خطابه حسب السياق. كما يمكن استخدامها
بدلالات تستمد معناها من تنوع البني، و حسب ما يجمع المفاهيم من شبكة العلاقات
"فكل مفهوم من تلك المفاهيم يوجد مرتبطا بمفاهيم أخرى وفق علاقة جوار"[8]
[1] ميشال
طوزي: الدراسة الفلسفية للموضوعة والنص، ص 70
[2] نفسه ص 70
[3] ميشال
طوزي: الدراسة الفلسفية الموضوعة، مرجع سبق ذكره، ص 95- 96
[4] مطاع
الصفدي: "في تبرئة الفلسفة من أوهام تاريخها"، مجلة الفكر العربي
المعاصر، 7
[5] ميشال
طوزي: "مدخل إلى إشكالية ديداكتيك تطم التفلسف" مرجع سبق ذكره، ص 10
[6] ميشال
طوزي: الدراسة الفلسفية للموضوعة و النص، مرجع سبق ذكره ص 96
[7] ميشال
طوزي: "مدخل إلى إشكالية تعلم التفلسف" مرجع سبق ذكره، ص 101