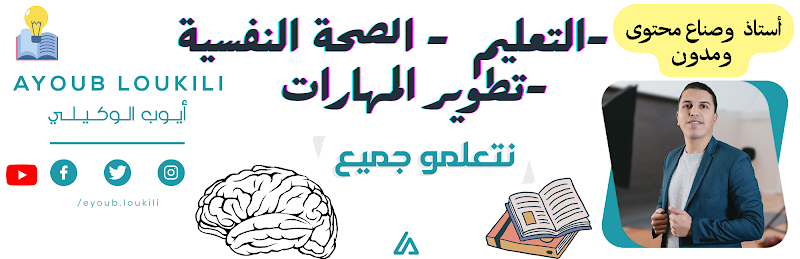إن الدرس الفلسفي مجال للمساءلة والنقد ، وخلخلة الأحكام المسبقة والجاهزة والقطع معها، كما أنه فضاء للحوار يسمح بالاختلاف و التعارض، و يدفع المتعلم إلى ممارسة التفلسف عبر النقد والمسألة والتحليل باعتبارها آليات التفكير الفلسفي المتميز بطابعه النقدي و بتحليله المنطقي على المستجدات البيداغوجية والوسائل التعليمية اعتقادا منا أن كسب رهان تجديد الدرس الفلسفي ومده بالحيوية وتفعيل أدواره البيداغوجية، بالخصوص في ما يتعلق بالمهارات الأساسية التي يستهدفها من أهمها الأشكلة و المفهمة و المحاجة المؤسسة.
إن عملية المفهمة،
تتجلى من خلال العمل على المفاهيم و الحفر في دلالتها والعلاقات بينها، فهي
عملية جوهرية لا يمكن تجاوزها في بناء الدرس الفلسفي، ذلك أن هذا الأخير يجعل من
المفهمة نشاطا رئيسيا له، ما دام المفهوم يحضر في كل خطواته و إن اللحظة المفهمة
الأولى تكمن في الاشتغال على تمثلات التلاميذ حول المفاهيم التي نتناولها، "
فلكي نجعل التلميذ يفكر لابد من استحضار تمثلاته لا التسرع في استبعادها لأن مفهمة
موضوعة ما هي عبارة عن مسار تفكيري، ويلزم لكي يكون هذا النشاط فلسفيا أن تتحول
الموضوعة للتلميذ إلى لغز في حاجة إلى حل"[1].
ولعل لحظة الاشتغال
على التمثلات، أي المواقف التي يحملها التلميذ على سبيل القناعة عن المفاهيم، ليست
مجرد آراء، بل ثابتة نسبيا، لأنها أحد مكونات الوعي الفردي والاجتماعي للتلميذ،
لذلك ينبغي علينا العمل على دفعهم إلى
مستوى أرقى في التفكير، هو مستوى الدلالات و التصورات العقلية عبر تشخيص تمثلاته و
تحليلها و نقدها، من أجل اكتساب مفاهيم كلية،" و من أجل الاشتغال العقلاني
الهادف نحو المفهمة (نحتاج) الاشتغال المعرفي على تمثلات دالة تكمن أساسا في كون
الترسيخ الوجداني للتمثل غالبا ما يكون عائقا أمام تطوره. و يمكن للمتوسط اللغة من
جهة، و للمواجه من جهة أخرى أن تسمح بوضع مسافة بيننا و بين التمثل، هذه المسافة
النقدية هي التي تساعدنا على صياغة إجراءات المفهمة"[2]
ومن خلال المفهوم
يمكن للمدرس أن يدفع التلميذ إلى التفكير في المفاهيم الفلسفية والتعامل معها عبر
النصوص، فرغم صعوبة التعامل مع المفاهيم الفلسفية، نظرا لكونها تتميز بالتجريد والتعميم، إلا أنه يمكن وضع المفهوم على محك السؤال مما يضمن من الناحية التعليمية
حركية على مستوى تفكير التلاميذ: و نشاطهم المتفلسف و المنظم داخل الدرس الفلسفي،
و بهذه الكيفية نستطيع إقحام التلميذ في التفكير الفلسفي عبر الانطلاق من أحكامه
الأولية وتمثلاته القبلية عن المفهوم والتدرج بها إلى مستوى لحظة المعرفة
الفلسفية.
أشكلة المفهوم، من أجل بناء التفكير النقدي:
وهذا القول يستمد
حجته من أنه ليس هناك تفكير فلسفي بدون مفهمة، و أهم خطوة في هذه الأخيرة هي
التناول الاشكالي للمفهوم، لما نعلم أن المفهوم ظهر في تاريخ الفلسفة في صورة
سؤال، لأن وضع المفهوم على محك السؤال كفيل من الناحية البيداغوجية أن يضمن لنا
حركية خصبة على مستوى تفكير التلاميذ، فكل جواب عن المفهوم يشكل محطة جديدة
للتساؤل عن طبيعة المفهوم الفلسفي و إعادة تأسيسه بشكل نقدي للمفاهيم و المقولات.
لهذا فالتناول
المفاهيم اشكاليا، يعتبر أساس بناء الدرس الفلسفي باعتباره استراتيجية في تعلم
التفلسف "إذن، فليس المفهوم هو مجموعة من القضايا و المواقف التي تستدعي التجميع،
بحيث يصبح درس الفلسفة من جرائها كتوليف مناسبة للمسائلة و الاستشكال"[3].
و من خلال وضع تمثلات
التلاميذ و تصوراتهم القبلية، و إجاباتهم العفوية حول المفهوم، للمسائلة و النقد
أي أشكلتها بهدف تبیان تناقضاتها و تهافتها و خطئها، أو على الأقل تبيان مدى
هشاشتها و عدم ارتقائها إلى مستوى التفكير العقلي. و بأشكلتنا لتمثلاتهم، "و
إدراك ما تنطوي عليه من مفارقات و تناقضات و القدرة على التساؤل فلسفيا"[4] ، نكون
قد وضعنا دلالات المفهوم العامية و المشتركة موضع نقد و مسائلة، بغية الولوج إلى
دلالاته الايتيمولوجية اللغوية، ثم وضع هذه الدلالات على محك النقد و المسائلة
لتبيان محدودیتها و قصورها على إدراك المعاني الفلسفية لهذه المفاهيم، و هنا نكون
على أعتاب الدخول إلى الاشتغال الفلسفي على المفهوم.
الاستخدام الفلسفي للمفاهيم المشتركة:
و لعل هاته الخاصية
التي ميزت المفهوم، هي السبب الذي جعل البرنامج الدراسي الفلسفة يعطيها قيمة، إذ
أن النصوص الفلسفية ليست مقصودة في ذاتها، بل المفاهيم التي تقدمها هذه النصوص هي
التي يتمحور عمل المدرس حولها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما طبيعة هاته المفاهيم؟
إذا كان ما يميز الفلسفة هو استعمالها الفلسفي اللغة، فيمكن سحب ذلك على المفاهيم
أيضا لا تبني مفاهيم خاصة بها بقدر ما تستعمل المفاهيم السائدة في الخطابات الأخرى
ربما قد يكون عملها منصبا أحيانا على إعادة النظر و إعادة تحديد المفاهيم السائدة
في الخطابات كثيرة، و "بذلك تكون صناعة المفهوم الفلسفي أرقی الصناعات
النظرية، و تكون نهاية المفهوم اللغوي هي بداية المفهوم الفلسفي و لعله الاعتبار
الذي دفع "غرانجي" إلى نعت المفاهيم الفلسفية بأنها مفاهيم المفاهيم أو مفاهيم
من الدرجة الثانية أو بعدية"[5]. بهذا
المعنى فإنه يصعب الحديث عن لغة فلسفية موحدة، غير أنه يمكننا الحديث عن استعمال
فلسفي للغة، فالفلسفة مفتوحة على مجالات مبنية سابقا داخل خطابات متعددة لأن كل
مفهوم يفتح على علاقة عميقة مع مفاهيم اخرى.
"و إذا كان
الخطاب العلمي أو الأدبي أو السياسي يبني مفاهيم خاصة حول تجربة ما، فإن الخطاب
الفلسفي يفكر و يتساءل حول هذه المفاهيم و يعيد إنتاجها. و ما يهم ليس حصيلة هذه
النتائج بل الانتاج ذاته، أي نمط التفكير الخاص بالفلسفة ذلك أن نمط استعمال
الفلسفة لتلك المفاهيم يكشف في العمق عند نمط عمل التفكير الفلسفي ذاته، و من ثمة
فلا يمكن الفصل بين مفهوم فلسفي و استعمالنا الفلسفي لهذا المفهوم"[6]، وعليه
فإن الخطاب الفلسفي قد يتساءل حول مفاهيم تتأسس و تتشكل في حقول أخرى (علمية،
أدبية، فنية) ويعيد إنتاجها، لأن الضرورة البيداغوجية تفرض فتح هذا الانغلاق
الفلسفي على مجالات الأخرى.
فالمقصود بالمفهوم (هو) ما ينتج عن التفكير الذي ينتقل من الموضوعة إلى مفهومها انطلاقا من فرضيتها. هذه ستتخذ كمرجعيات الفلسفات التي تعتبر أن المفهوم ليس في متناول متعلم الفلسفة، ولكن يتم بناؤه من خلال تفكير خاص ( و يعاد التفكير فيه في حالة ما إذا تم بناؤه فيما قبل من طرف الفيلسوف) ، كما سنعتمد من أجل تحقيق مرامينا الديداكتيكية على مرجعيات النظرية البنائية بصدد التعلم. إن مفهمة الموضوع ما هي إلا سيرورة تفكير، و بالتالي فهي تعني أن نبني فلسفيا مفهوم الموضوعة"[7].
خلاصات عامة:
بناء على ذلك فإن
المفاهيم داخل الدرس الفلسفي أدوات للتفكير و ليست معطيات للمعرفة الجاهزة حول
المفاهيم. و هذا ما ينبغي أن يحصله المتعلم في الدرس، وليس المعرفة الجاهزة حول
هاته المفاهيم، بل التفكير فيها. و المقاربة المفاهيمية داخل الدرس هي مجموعة من
الاجراءات التعليمية التعلمية، و بذلك تحضر النصوص كأدوات للاشتغال يظهر فيها
إجرائيا جوهر تلك العملية، فلا يمكن للمتعلم أن يفكر بشكل مجرد في مفاهيم بالغة
التجريد بل لابد من أدوات لغوية ينصب عليها التفكير، هي النصوص الفلسفية.
"فالمفهوم
الفلسفي يكون بنائيا عندما يتم النظر إليه في وظيفته الإجرائية التنظيمية، بوصفه
يعمل من خلال هذه الخاصية على تنظيم المجال الداخلي للخطاب الفلسفي بما يضمره أو
يعلنه من تحديدات. تسهل عملية استيعاب ذلك الخطاب، و تضمن من هنا قدرة تواصلية"[8] و بذلك فإن تعلم التفلسف هو أن نتعلم كيفية بناء
المفهوم مع التلاميذ. "لأن الأهمية كامنة في مقدرة التلميذ على بناء التعريف
بنفسه"[9]
ومن هنا تصير عملية التفلسف كممارسة ذاتية يعيد فيها التلميذ النظر في آرائه و من
أجل تفكيكها و إعادة بنائها بطريقة شخصية "فالمفهوم من منظور تعلم التفلسف هو
أن يكون التلاميذ، كل التلاميذ في وضعية نشاط يدفع نحو الفلسفة"[10].
و عليه نستنتج أننا
في درس الفلسفة لا نؤسس مفاهيم جديدة، بل هي مفاهيم معطاة نبنيها مع المتعلم، و
بذلك " فإن الغاية من درس الفلسفة ليست هي تعليم مضامین معرفية أو معارف
محددة. بل هي تعليم كيفية التفكير في معنى المضامين التي تشغلنا في هذا العالم، فالمعاني
و الدلالات التي تحملها المفاهيم داخل النص ليست جاهزة، إنما يتم بناؤها، و ذلك
"ما يدعوه طوزي Tozzy
بدفع المتعلم للاشتغال على تمثلاته بنفسه، حيث يقوم المدرس كوسيط، باقتراح دعائم
تلعب دور المحرض على عملية التفكير "[11] .
خاتمة:
نخلص مما سبق أن المفهوم يحتل إلى جانب الأشكلة
و المحاجة مكانة في الدرس الفلسفي، ومن هنا لا يجب أن ننظر إلى المفاهيم ككتلة
صماء، لأنها مدخل أساسي لتأسيس خطاب معرفي في الدرس الفلسفي، ما دام المفهوم يهدف
إلى استنطاق الكلمة و تحديدها بما يكفي من الدقة حتى تصبح مجالا للتفكير الفلسفي،
و أداة للتفلسف، فالمفاهيم إذن تكون موضوعا للأشكلة و موضوعا للمحاجة التي ينبغي
أن يقوم بها التلميذ خصوصا و أن تمفصل هذه السيرورة ( المفهمة، الأشكلة، المحاجة) يكشف
عن قدرة الذات على طرح السؤال و نقد و دحض الآراء، و محاولة حل المشاكل التي تعترض
الفكر، وهو الأمر الذي يساهم في "تنمية شخصية الفرد و انخراطه في الحياة
العملية، و هذه إحدى الغايات الأساسي لعملية التكوين الذاتي"[12] بهذا
المعنى فإن الكفايات الأساسية التي تسعى الفلسفة إلى تحقيقها، تتجلى في قدرة
المتعلم على التفكير بطرقة ذاتية مستقلة، تمكن من بناء ذات مستقل معرفيا ونفسيا،
وقادر على التفكير والتساؤل حول ذاته والعالم الذي يعيش فيه.
[1] ميشال
طوزي: الدراسة الفلسفي للموضوعة و النص، مرجع سبق ذكره، ص 46.
[2] ميشال طوزي: المرجع نفسه، ص 52.
[3] عز الدين
الخطابي: مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب حوار الفلسفة و البيداغوجية، منشورات علم
التربية، 2001، ص 95- 96.
[4] عز الدين
الخطابي، المرجع نفسه، ص
[5] عبد الله
الطني: معجم الفلسفة الفرابية مقاربة تكميلية، مرجع سبق ذكره، ص 93۔
[6] عبد الله الطني: معجم الفلسفة الفرابية مقارية تكميلية، مرجع سبق ذكره، ص93
[8] عبد الله
الطني: معجم الفلسفة القرابية مقاربة تكميلية، مرجع سبق ذكره، ص 93
[9] ميشال
طوزي: الدراسة الفلسفية للموضوعة و النص، مرجع سبق ذكره، ص 46
[10] ميشال
طوزي، المرجع نفسه، ص 68
[11] عز الدين
الخطابي: مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب حوار الفلسفة و البيداغوجيا ص 77
[12] ميشال
طوزي: مدخل إلى إشكالية ديداكتيك تعلم التفلسف، مرجع سبق ذكره، ص 101.