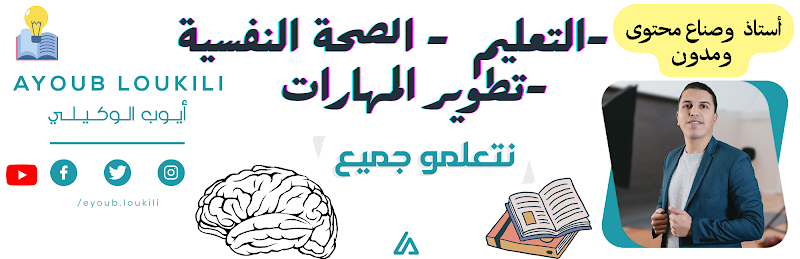المفهوم الفلسفي: من التحديد النظري إلى التوظيف الديداكتيكي
مدخل:
في هذا العرض سنركز على الجوانب التربوية والتعليمية الأساسية التي نحتاجها من أجل
بناء الدرس الفلسفي مع المتعلمين، بالخصوص بناء المفاهيم حيث
يصبح التلاميذ قادرين على بناء المفاهيم بشكل ذاتي، بعد أن نمدهم بخطة ورؤية واضحة
للتعلم الذاتي ، لذلك فإن تشكل المفاهيم في النص الفلسفي، عملية بنائية للغة الطبيعية، تنقل الألفاظ أو الكلمات، من
المحسوس إلى المجرد فهي بناء العالم من الدلالة يجعل الجزئي والحسي يتخذ طابعا
عقليا.
وذلك عبر خلخلة تمثلاته
ومراجعتها، بغية دفع المتعلم إلى إعادة تملك هذه المفاهيم فلسفيا، وامتلاك القدرة
على مساءلة المفاهيم المماثلة التي يواجهها المتعلم في حياته اليومية، والقدرة
الذاتية على أشكلتها، لكي يتمكن الوعي من التحرر الحقيقي، بأن يغدوا قادرا على
بناء ذاته بشكل مستقل عن أي استلاب أو انغماس في تفاهات المعطى اليومي، و تمكين
المتعلمين من التفكير بشكل عقلاني، يقوم على المساءلة والنقد، وإعادة النظر في
الدلالات والمعاني التي يشكلها الإنسان حول ذاته و العالم الذي يحيط به.
1-أهمية المفهمة في بناء الدرس الفلسفي
يشكل المفهوم النواة
الأساسية داخل النشاط الفلسفي، و يستلزم تدريسه من أستاذ الفلسفة أن يبذل مجهودا
كبيرا و يجعل منه هدفا رئيسيا للعملية التعليمية التعلمية التي يقوم بها مع
تلاميذه. لأن التركيز على المفهوم كحجر الزاوية في تدريس الفلسفة يجعلنا إذن أمام
مهمة تجعل من المفهوم عنصرا أساسيا داخل نشاط التدريس، لذا نحتاج البحث عن الوسائل و الأدوات والطرق و
المناهج التي تسهل عملية تدريسه.
التدريس بالموضوعات: les notion
إذا انتقلنا إلى مقرر
الفلسفة خلال العقد الأخير من الزمن عرف تغيرا جذريا، تمثل في مستواه النظري، في
تبني اختيار تدريس الفلسفة من خلال المفاهيم les notions، نظرا للأهمية التي أضحى يوفرها بالنسبة للمتعلم نظريا و سيكولوجيا، إذ أصبح التدريس يمثل
عتبة اللقاء بين المتعلم والنص الفلسفي من جهة، و اللقاء مع القضايا الفلسفية من
جهة ثانية.
والهدف من هذه الالية البيداغوجية، هو وصل
العلاقة بين المتعلم و آليات التفكير الفلسفي. حيث اخترنا المفهمة كهدف نواتي،
من أجل تحقيق الوصل بين المتعلم والنص الفلسفي،" لأن تعلم التفلسف لدى
التلميذ يفترض بالنسبة إلينا أن يتورط هو شخصيا في تفكريه بصدد الموضوعات"[1]، بحيث لا
يمكن الاشتغال على الموضوعة دون تطوير عملية القراءة و تنظيم المعلومات، و ذلك
انطلاقا من النصوص الفلسفية، لأن مجال تدريس الفلسفة في المنهاج الجديد، أضحى
متمحور حول كيفية استثمار النصوص الفلسفية، و لعل مفتاح النفاد إلى فهم النظريات
الفلسفية بصورة عامة يبقى هو المفهوم، فهذا الأخير يمكنه أن يكون: "مجالا للبحث عن المعنى سواء عن طريق التعارض بين المفردات والأضداد أو عن طريق التمييز بين الاستعمال المألوف
و الاستعمال الفلسفي، أو التمييز بين المذاهب الفلسفية"[2]،
من هنا يكون المفهوم في درس الفلسفة بمثابة المفتاح
الذي يمكن المتعلم من فتح ما استغلق في النصوص الفلسفية، و الجسر الذي لا بدا العبور
عبره لفهم هذه النصوص وتوظيفها، فرهان التفلسف "على مستوى الموضوعة هو بلوغ
المفهوم و إدراكه في وحدته وفي تعدده"[3] ، فمن
خلال النصوص نكسب التلاميذ ثقافة فلسفية في شكل مقولات و مفاهيم مستمدة، من تاريخ
الفلسفة، تسمح لهم بالانخراط في لحظات محددة للخطاب الفلسفي.
أهمية المفهمة في الدرس الفلسفي:
و من هذا المنظور،
فإن المفهمة تتمثل في إبراز أو بناء معنى الموضوعات التي تتحول من مجرد أفكار إلى
مفاهيم محددة، و هي في نفس الأن، موضوع وأداة التفكير، ويمكن إنجاز المفهمة عبر
ثلاثة لحظات:
"1لحظة البحث ومن خلالها، فكل موضوعة يتم
التعبير عنها في كلمة، تكون مجالا للبحث عن المعنى ( موضوعة الحق مثلا )؛ 2- لحظة
خلخلة التمثل والانفصال عنه، وهي لحظة تبرز أهمية الانطلاق من تمثلات المتعلمين و
معالجتها عن طريق التفاعل السوسيو-معرفي ؛ (في اتجاه تجاوزها إلى مستوى أرقی)، 3-لحظة
التخصص حيث تستخدم المفاهيم باعتبارها أداة لعقلنة الواقع، مما يحيل على حقولها
التطبيقية المتعددة ( في: المجال القضائي و الديني و السياسي و الفلسفي بالنسبة
الموضوعة الحق باعتبارها مثال"[4]
و إذا كانت اللحظة الأولى تعطي إمكانية الاشتغال على مضامين فكرية كلية، عبر القواميس والنصوص و الدراسات الأكاديمية، فإن اللحظة الثانية تشتغل على تمثلات التلاميذ و إمكانية نقدها في اتجاه اكتساب مضامين فكرية كلية يصوغها الخطاب الفلسفي، أما اللحظة الثالثة فتسمح على المستوى الديداكتيكي بتنوع مجالات الموضوعة و التي يمكن التفكير فيها انطلاقا من مجالات مختلفة كالفن، الطبيعة، السياسة و الأخلاق .... إلخ.
وإضاف
إلى ذلك فإن، "الموضوعة تسمح
بالتفكير في علاقة مع الفكر من جهة والحقل
الدلالي) ، و علاقة الفكر بالواقع ( التمثلات) ، ذلك أن الموضوعة تدخل في نظام
علاقتنا مع العالم الآخر ومع ذواتنا ... و الأساسي هو أن يكون التلميذ في صلب
التفكير في الموضوعة، وأن يتحسس تورطه كذات تحمل تمثلات" [5].
كما أن الموضوعة،
ليست مفهوما لكنها قابلة لكي يتم التفكير فيها بواسطة المفاهيم، لذا ففي المفهمة Conceptualisation لا يعني بناء المفهوم الكلمة لأن "نفس
المفهوم يمكن أن يشار بكلمات مختلفة (...) ومع ذلك فالقارئ على صلة مع الكلمات،
يلجأ الكاتب . الفيلسوف - إلى الكلمات المشتركة بين الجميع و التي تكون نتيجة ذلك
معرفة بشكل شيء، يلجأ إليها لكي يحدد مفاهيمه الخاصة، إن الوسيلة الوحيدة الكفيلة
بتحقيق ذلك هي نسج شبكة من العلاقات بين هذه الكلمات، بحيث تتداخل فيما بينها و
يعرف بعضها بعضا"[6]، لأن كل
تعريف للمفهوم هو عبارة عن نفي له، و هذا يعني أن كل فيلسوف يشتغل على اللغة
بإدخال علاقات دلالية جديدة، لأنه "لا وجود لمصطلح تقني للفلسفة ككل... إن
المصطلح الفلسفي لا يحمل معناه في ذاته، بحيث يمكن نقله من تحليل فلسفي لآخر و من
مذهب لآخر كما هي الحال في المصطلحات الرياضية التي تحتفظ بنفس التحديد في
المبرهنات، إن السمنطيقا الفلسفية ليست من النمط المعجمي بل الفكري، فالمعجم لا
يمكن أن يغنينا أبدا عن البحث عن معنى المصطلحات من خلال فكر الفيلسوف و الصيغ
التي عبر بها عن تلك الفكرة"[7]
[1] عزيز
الأزرق: أسئلة الفلسفة ورهانات تدريسها، مطبعة المغاربية اتقان سلا، 1997 الطبعة
الأولى، ص 16.
[2] ميشال طوزي، "مدخل إلى إشكالية ديداكتيك تعلم التفلسف"، ترجمة عزيز أزرق، مجلة فلسفة عدد 7-8، ربيع 1999،ص 100
[3] ميشال طوزي، "الدراسة الفلسفية للموضوعة و النص"، ص 8
[4] المرجع
نفسه، ص 101.
[5] عزيز
الأزرق: أسئلة الفلسفة و رهانات تدريسها، مرجع سبق ذكره، ص 71.
[6] ميشال
طوزي: الدراسية الفلسفية للموضوعة، ص 95
[7]مصطفی بلحمر: "في ديداكتيك النص الفلسفي". مجلة ديداكتيكا
العدد 2، ص 36