المطلوب من التلاميذ أثناء كتابة المقدمة: التركيز
على العناصر الأتية:
ü تحديد موضوع النص أو القولة أو السؤال ومجاله
ü صياغة الاشكالية أو عناصر المفارقة أو الاحراج...
ü طرح الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة.
كيف نطرح المفارقة؟ ما هو الطرح الإشكالي:
يُقصد بالطرح الإشكالي لموضوع ما، بيان أوجه
إشكاله، ويطلق على هذه العملية في الكتابة الفلسفية الاستشكال La problématisation،
ويتم هذا الفعل من خلال طرائق عدة منها: أساليب مختلفة: (الشك، الارتياب، المواجهة، المجاوزة، الدهشة،
الحيرة،...) بحيث يصير كل موضوع موضع استشكال.
لأن الغاية ديال
الطرح الإشكالي هي المهيد لوحد المشكلة لي غاذي نكشفوا على الخبايا ديالها في
التحليل، على نحو يجعل اثارة التساؤلات حوله أمرا لا مفر منه ومسوغا يجعل كل تساؤل
عنه مشروعا، بل وضروريا.
1-الشك: وضع الموضوع محل النظر بالتشكيك
في صحته أو وضوحه، أو إطلاقه أي اعتباره
أمرا لا يسلم بيقينه، رغم كونه مما عُهِدَ، في التوجه النظري العام، كونه مما حكم
بقَبُول أو صدقه.
2-الإرتياب: الارتياب من صحة فكرة ما حول
الموضوع على نحو يجعله أمرا” مُشْكِلاً“أو قضية ”مُشكِلة“، أي بمنزلة الأمر الذي
يستدعي حلا لرفع الريبة.
3-المواجهة: أي ابراز التناقض الذي يعتري
التصورات حول الموضوع بحيث يصير أمرا خلافيا يتعين حسم الخلاف حوله.
4-المجاوزة: أي ابراز إحتمال أن يكون حل
الموضوع على غير ما تم فعله أو كونه على غير ما يبدو عليه فتطرح التساؤل لما لا
يكون الأمر خلاف ذلك. pourquoi pas
5-الدهشة: أي جعل الموضوع مثار استغراب
وتعجب، أي مثيرا للدهشة وكأنك أمام لغز، رغم ألفته أو بساطته.
6-جعل الموضوع بموضع الأمر
المحرج الذي يثير ترددا وارتباكا أي حيرة ذهنية أو واقعية، للأنا أو للغير رغم
عفويته وسذاجته.
تأتي الأسئلة في الخاتمة بعد الطرح
الإشكالي:
Ø بالنسبة للنص يجب
تحويل الأطروحة إلى مجموعة من الأسئلة وتتحول أطروحته لتساؤل وتصير عناصر مناقشته احراجات استفهامية
بدورها.
Ø في القولة:
في الاشتغال على القولة المرفقة بمطلب وسؤال تستمد الأسئلة الموجهة للتحليل
والمناقشة من الاشكالية التي تتناولها القولة ومن السؤال المرفق بها.
وهكذا فإن صياغة الأسئلة مثلما هي صياغة مطلب الفهم ككل تأتي ختاما بعد
انجاز عملية التحليل والمناقشة المتأنية للموضوع الذي نتطرق له سواء كان المنطلق:
سؤال او قولة أو نص. (وهو ما ينجز على مستوى المسودة)
نماذج تطبيقية كيف نكتب مقدمة
1-الانطلاق من رأي شائع حول الموضوع واستشكال
الرأي الشائع: يمكن باش نبين المفارق نطلق من الأفكار
الرائجة والمقبولة
والمتداولة، حول قضية ما، يتحول للحظة دهشة فلسفية، تفرض التساؤل والاستشكال أي
أننا نضعه موضع تشكيك أو إحراج أو تأزيم بيانا لتناقضه أو عدم كفايته أو عدم
وضوحه، وبذلك نبين المشكلة التي قد تتولد عنه والتساؤل الذي يفرضه.
¨
مثال: المعطى سؤال إشكالي مفتوح: من أين يستمد
الشخص قيمته؟
يثير السؤال الذي بين
أيدينا موضوع مصدر قيمة الشخص، والحال إن هذه القضية تندرج بشكل عام ضمن مجال
التفكير الفلسفي، في شروط الوجود الإنساني في بعده الذاتي والعلائقي. فإذا كان
يسود الاعتقاد في بعض المجتمعات أن قيمة الشخص تكمن في نسبه وحسبه أو فيما يمتلكه
من ثروة أو ما يحوزه من سلطة ونفوذ إجتماعي أو ما يميزه من جمال وقوة جسمية، فإن
هذه التصورات محل شك، إذ شأن هذه المظاهر أن تكون مؤقتة تقبل الزوال وأن تكون خاصة
غير عامة بين جميع الناس.
فهل معنى ذلك أن بعض
الناس فقط من لهم قيمة؟ ألا يتعارض ذلك ومبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية؟ وإذا
كان الأمر كذلك، فمن أين يستمد الشخص قيمته؟ هل من كونه غاية في ذاته أم في
اعتباره مجرد وسيلة؟ بعبارة أخرى هل قيمة الشخص ذاتية يستمدها من ذاته أم اجتماعية
يستمدها من دوره في المجتمع؟ وهل هي مطلقة أم نسبية؟
هنا جاءت التساؤلات بصغة تحفز التلاميذ على استثمار المواقف بطريقة يكون التصور الأول هو التصور الكانطي والمناقشة يمكن أن نتكلم عن تصور ....
2-الانطلاق من المفارقات التي يطرحها موضوع الامتحان:
Ø
ماهي المفارقة paradoxe بمعناها الفرنسي هي كلمة مركبة
من كلمتينpara وتعني خارج أو ضد... وdoxa وتدل
على الرأي الشائع بين عامة الناس.
Ø
المفارقة
إذن وفقا لهذا السياق هي فكرة تطرح حيرة واحراجا مربكا للتفكير فيما هو متداول،
بأن تعيد مساءلة هذه الأفكار المقبولة المتداولة داخل المجتمع أو في مجال ما على
نحو يضعها في إحراج.
Ø
إنها
اقرار بأمر يستفز الفكر ويخلق التوتر فالمفارقة علاقة من نوع خاص بين مفهومين أو
فكرتين، يستبعد أحدهما الأخر ويستدعيه في الوقت نفسه، مما يفرض التساؤل.
Ø هنا يمكن نعطيو مثال:
من القولة المرفقة بالسؤال: يقول لايبنتز:” إن الرأي القائم على الاحتمال، قد يستحق اسم المعرفة، وإلا سوف يتم إسقاط كل معرفة تاريخية، وغيرها من المعارف" اشرح مضمون القولة وبين(ي) ما طبيعة العلاقة بين الرأي والحقيقة؟
Ø
يطلب منا تناول قولة لايبنتز في ضوء مشكلة
العلاقة بين الرأي والحقيقة، وهي قضية جوهرية في تناول إشكاليات المعرفة بمختلف
مظاهرها.
Ø لهذا فالقولة تعالج علاقة الرأي بالمعرفة. فإذا اعتبرنا مبدأيا أن المعرفة تحيل لما يكون
حقيقيا، فإن المفارقة التي تطرحها هذه الإشكالية حول العلاقة بين الرأي والحقيقة
إنما حضورها من أن الرأي، مفهوم يرتبط بالقول الشائع أو الظن، ويعبر عن التعددية.
فكل إنسان يزعم أن له رأي، مثلما قد يدل على القول المتداول بين الناس في مقابل الحقيقة التي تحيل بخلاف ذلك إلى اليقين والموضوعية، وغالبا ما ترتبط بفئة معينة هي فئة العلماء والحكماء. لكن هذا التقابل يطرح مفارقة عند استحضار تاريخ المعرفة العلمية حيث نجد في أحيان كثيرة، الآراء المتداولة تصير ذات صبغة يقينية، وبالمقابل نجد أن الكثير من الحقائق العلمية والفلسفية، تصبح ذات طابع احتمالي ويتم تجاوزها في الكثير من الأحيان، فهل معنى ذلك أن العلاقة بين الرأي والحقيقة، علاقة اتصال وتكامل أم أنها علاقة انفصال وقطيعة؟ وما المعيار الذي يمكننا من الفصل بينهما، إن كانا متناقضين؟ وكيف نفهم الاتصال بينهما وتكاملهما؟ هل بمنطق التماثل أم التعاقب؟
3- الانطلاق من التقابلات الممكنة بين المفاهيم
الأساسية:
التقابل بين المفاهيم: هو الوقوف على المتعارضات
الجزئية أو الكلية بين مفاهيم موضوع ما على نحو يخلق التوتر والارتياب والحيرة في
صلة بعضها ببعض مما يستدعي التساؤل عن مدى دقتها وصحتها، أو عن حقيقة الصلة بينها.
Ø
مثال
من القولة التالية:
” لا يكون الشخص شخصا إلا بتوجهه نحو الغير، ولا يعرف ذاته إلا من خلال الغير، ولا وجود له إلا بالغير” اشرح مضمون القولة مبينا أي مكانة للغير في وجود الشخص؟
تعالج القولة الماثلة بين
أيدينا، إشكالية العلاقة بين الشخص والغير الذي يوجد ضمن المجال الإشكالي العام
لمجزوءة الوضع البشري، إذ تطرح مشكلة العلاقة الشرطية بين وجود الشخص ووجود الغير،
بحيث الأخير شرط للأول، لكن إذا كان الشخص هو الذات الفردية أي الكائن المتمتع
بهوية تميزه عن غيره من الأشخاص والأشياء، هوية تتجلى في استقلالية مادية تتمثل في
الجسم واستقلالية معنوية تتمثل في الفكر والشعور.....
وإذا كان الغير هو الذات الأخرى، الآخر
المختلف عن الذات والمتمايز عنها، فكيف يكون الغير شرطا لوجود الشخص رغم ما بينهما
من تمايز واستقلالية؟ وإذا كان الوعي بالذات ومعرفتها أمر ذاتي، فكيف يكون الغير
شرطا لمعرفة الذات بذاتها؟ أليس وجود الغير بالأحرى مجرد وجود إحتمالي وجائز ويمكن
الاستغناء عنه؟ ألا يشكل بالأحرى وجود الغير تهديدا لوجود الذات ووعيها بذاتها؟
المراجع المتعتمدة:
1- كتاب التوجيهات
التربوية الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي مادة الفلسفة،
مديرية المناهج التربوية، وزارة التربية الوطنية، المملكة المغربية.
2- وثيقة
الأطر المرجعية المحينة لمواد الإمتحان الوطني الموحد للبكالوريا – 2014، مادة
الفلسفة. المذكرة رقم 093 / 14 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2014م.
3- كتاب:
كريكر شفيق، بوتنبات محمد، الخلوفي محمد، منهجية الإنشاء الفلسفي، افريقيا الشرق،
المغرب، ط1، 2014م
4- كتاب:
بودية، شفيقة الشعبوني، من الموضوع إلى المقال الفلسفي، دار الجنوب للنشر، تونس، ط1، 1990م
5- كتاب:
النقاري، حمو. روح التفلسف، المؤسسة العربية للفكر والابداع، بيروت، ط1، 2017م
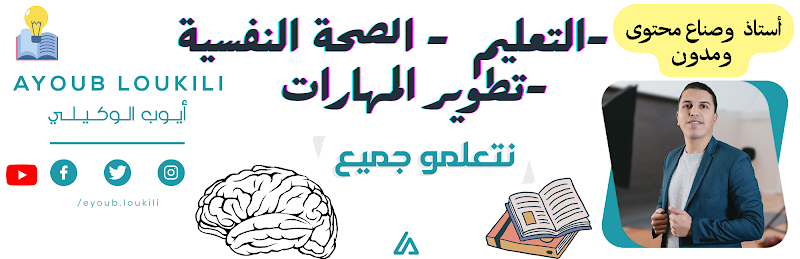

.png)