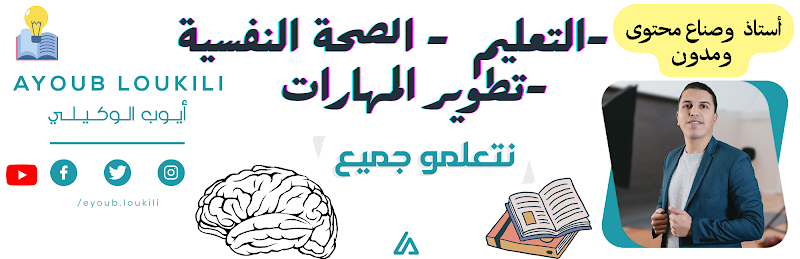المقاربة بالكفايات وتدريس في المنهاج المغربي
مدخل:
أظهرت الدراسات
الميدانية عن عجز المتعلمين عن استثمار ما اكتسبوه في مؤسساتهم التعليمية، من
معارف ومهارات وقيم وغيرها، في حياتهم العملية، الاجتماعية والمهنية، في ظل
مقاربتي التدريس بالمضامين والأهداف، الشيء الذي دفع الخبراء البيداغوجيين عبر
العالم إلى البحث عن مقاربة جديدة في التربية والتكوين ذات فعالية ونجاعة، بدل شحن
المتعلمين بمعارف غير مجدية.
البحث عن نموذج يلائم المتعلمين ويحفزهم على التعلم:
من هنا جاءت
مقاربة التدريس بالكفايات كبديل موضوعي عن البيداغوجيتين السابقتين، البيداغوجيا
المضامينية المثقلة بمحتويات غير ضرورية للحياة العملية، وبيداغوجيا الأهداف التي
عادة ما تقدم المادة التعليمية على شكل ممارسات مجزأة وتبسيطية واختزالية وتراكمية.
هكذا ظهرت
مقاربة التدريس بالكفايات لتعيد النظر في وظيفة المدرسة التي لا تنحصر فقط
في تزويد الأفراد بمعارف ومهارات وقيم، ولكن أيضا الانفتاح على رهانات المجتمع
الملحة، حيث تكوين مواطنين تكوينا أساسيا عبر إكسابهم كفايات تؤهلهم وظيفيا
ليتحملوا مسؤولياتهم المختلفة، ويتمكنوا من القدرة على الاستقلالية والتعلم
الذاتي.
من أجل تحقيق تنمية شاملة على مستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، استنادا إلى مقتضيات فلسفة التربية، في ضوء الوثائق الرسمية، بدءا من
الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرورا بالكتاب الأبيض، وانتهاء بقانون الإطار
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
لهذه الأسباب تم اعتماد مقاربة التدريس
بالكفايات كاختيار بيداغوجي استراتيجي، يجعل المتعلم محور العمليات التعليمية -
التعلمية، من خلال الانطلاق من هويته وشخصيته ذات الأبعاد المختلفة، وكذا واقعه
وحاجاته وتطلعاته... بهدف تحويله إلى عنصر فاعل داخل منظومة التربية والتكوين،
يوظف كفايات أساسية تشكلت لديه عبر اكتسابه لمعارف وقدرات ومهارات وقيم، في سياق تعليم تشاركي يتسم بجودة المردودية
والإنتاجية.
أهم نظريات علوم التربية في مقاربة التدريس بالكفايات:
تنفتح مقاربة
التدريس بالكفايات على حقول علوم التربية، خاصة سيكولوجيا التربية (نظريات النمو
والتعلم) وسوسيولوجيا التربية وكذا المقاربات البيداغوجية الحديثة... هذا الانفتاح
يتم في سياق التأكيد على مركزية المتعلم، وتحويل المدرس إلى مجرد منشط وموجه، بهدف
إشراك المتعلمين في بناء تعلماتهم وتعزيز ممارساتهم لفعل التفلسف، في
إطار إشكالات ومفاهيم وأفكار فلسفية في سياق معالجة مواضيع ضمن وضعيات واقعية أو
مصطنعة (ديداكتيكية)، من أجل البحث عن المعنى والحقيقة والفائدة.
ما المقصود بمقاربة التدريس بالكفايات؟ وما دلالة مفهوم الكفاية وما أنواع الكفايات ومبادئها وخصائصها ومرتكزاتها النظرية؟ وكيف يمكن توظيفها بيداغوجيا؟
الإطار المفاهيمي لـ"مقاربة التدريس بالكفايات":
يشكل التدريس بالكفايات مقاربة منهاجية (Approche curriculaire)، تُعتبر أداة لتخطيط وتدبير وتقويم المناهج والبرامج الدراسية. تمثل هذه المقاربة إستراتيجية بيداغوجية وديداكتيكية من أجل تحقيق الكفايات المنشودة. وهي توظف ترسانة جد هامة من المقاربات البيداغوجية النشيطة والتشاركية، التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية - التعلمية، ومنها: بيداغوجيا حل المشكلات، بيداغوجيا المشروع، البيداغوجيا الفارقية، بيداغوجيا الخطأ، بيداغوجيا اللعب، دينامية الجماعة وتنشيط التواصل...
مفهوم "الكفاية" (la compétence):
ظهر مفهوم
"الكفاية" في عالم الشغل في المنتصف الثاني من القرن العشرين، ثم انتقل
إلى الحقل التربوي. وهو يعني القدرة على إنجاز عمل أو مهمة، في سياق وضعية مهنية،
بدقة وإتقان.
وفي مجال
التربية والتعليم عَرف فيليب بيرنو (Philippe Perrenoud) الكفاية بأنها " القدرة على تعبئة مجموعة
من الموارد المعرفية) معارف، وقدرات، ومعلومات، إلخ(، بغية مواجهة
جملة من الوضعيات بشكل ملائم وفعال"[1].
إن اكتساب المتعلم لمجموعة من الكفايات ضمن وضعيات ديداكتيكية تستلزم منه معالجة مشكلات اعتمادا على موارده الذاتية (معارفه، قدراته، مهاراته، قيمه...) وموارد زملائه ووسطه المدرسي والاجتماعي. الكفاية إذن بمثابة هدف عام يشمل كافة التعلمات (معارف، مهارات، قدرات، معرفية/ وجدانية/ حس – حركية...) في مستوى دراسي معين أو عند نهاية مرحلة تعليمية محددة، أي مجموع القدرات والمهارات والقيم التي اكتسبها المتعلم بنجاح، والتي يُمكن توظيفها لحل مشكلة قائمة أو مواجهة وضعية طارئة، قد يتعرض لها مستقبلا في وضعيات شبيهة بالوضعيات التي أنجزها في برنامج دراسي محدد.
المفاهيم المجاورة لمفهوم "الكفاية":
مفهوم "القدرة" (capacité):
القدرة، حسب فيليب ميريو (Philippe Meirieu)، هي التمكن بنجاح في إنجاز نشاط ثابت قابل للنقل في حقول معرفية مختلفة [2]. إذ تعبر القدرة على ما يمكن أن يقوم به المتعلم من أنشطة على المستوى المعرفي أو الوجداني أو الحس- حركي أو المنهجي، حيث عتعبر القدرة على من الإمكانات التي تمكن فردا من بلوغ درجة من النجاح في التعلم أو في أداء مهام مختلفة.
أمثلة: القدرة على الحفظ تشمل كل ما يمكن حفظه، ولا تقتصر فقط على حفظ أفكار
أو نظريات بعينها...؛ القدرة قد تكون معرفية (الكتابة الخ) أو
اجتماعية (التفاعل...) أو سيكو – حركية (الرسم...)؛ القدرة على
الفهم والتحليل والمناقشة والتركيب...
ويمكن لقدرة واحدة أن تختلف بحسب المجالات: (مثلا الكتابة)
- القدرة على الكتابة في المجال المعرفي:
معرفة ما يمكن كتابته.
- القدرة على الكتابة في المجال الحس – حركي: رسم
الحروف والكلمات...
- القدرة على الكتابة في المجال السوسيو اجتماعي: التعبير عن الرأي والتواصل
مع القارئ...
خصائص القدرة:
- خاصية التطور :(Evolutivité) يتطلب تحصيلها واكتسابها وقتا طويلا تنشأ فيه وتنمو وتتطور.
- خاصية الامتداد (transversalité) في حقول معرفية أخرى، إذ لا ترتبط بموضوع في حقل معين.
- خاصية التحول (Transformation) مثال القدرة على التواصل تتحول إلى قدرة على التفاوض...؛
- خاصية عدم قابلية التقويم (Non évaluabilité)، إذ من الصعب قياس مستوى التحكم في قدرة.
مفهوم
"المهارة" (Habilité):
- "المهارة" أكثر تخصيصا من القدرة، فهي تتمحور حول نشاط
معين قابل للملاحظة.
-
"المهارة" هي التمكن من أداء مهمة محددة بدقة وإتقان، من خلال التدريب المتواصل والمحكم.
أمثلة:
·
مهارة استثمار المعرفة الفلسفية في سياق معالجة إشكال فلسفي.
·
مهارة تدوين رؤوس أقلام نص فلسفي.
·
مهارة توسيع فكرة واردة في قولة فلسفية بالشرح والتوضيح.
·
مهارات القراءة الفلسفية والكتابة الفلسفية والمناقشة الفلسفية.
· مهارات الابتكار والتكيف والإبداع وتنمى بالعمل الذاتي والجهدي الشخصي...[3]
الاستعداد (aptitude)
يشير الاستعداد إلى القابلية أو الأهلية لممارسة الكفاية [4]. الاستعداد هو بمثابة حافز سيكولوجي داخلي للإنجاز الذي يتطلب الميل والرغبة؛ - الاستعداد هو تأهيل الفرد لأداء معين، بناء على مكتسبات سابقة، منها القدرة على الإنجاز والمهارة في
1- مقابلة أجريت مع فيليب بيرنو حول موضوع
"بناء الكفايات" ، منشور في كتاب باولا جونتيل وروبيرتا بنتشيني،
الكفايات في التدريس بين التنظير والممارسة، ترجمة محمد العمارتي والبشير
اليعكوبي، مطبعة أكدال، الرباط ، الطبعة 1 ، سنة 2004، ص.41.
[2]
Meirieu Philippe, Apprendre… Oui, mais comment ? Paris, ESF, 5°éd.
1990, p.181.