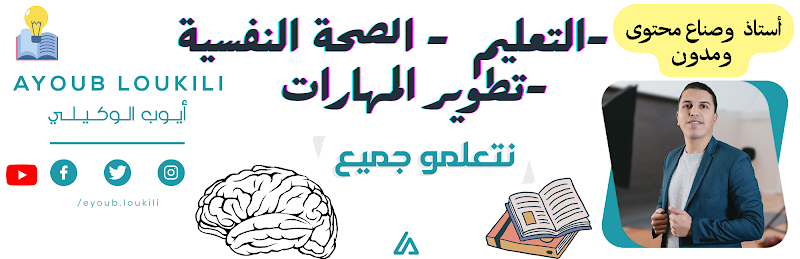البيداغوجيا
الفارقية (Pédagogie
différenciée)
تتعامل البيداغوجيا التقليدية مع التلاميذ باعتبارهم يشكلون فئة واحدة متجانسة، تعمل بنفس الطريقة والإيقاع، رغم اختلافاتهم على مستوى النمو والاكتساب. هذا الأسلوب في التعامل لصالح التلاميذ المتفوقين دون المتوسطين والضعاف، يعمق الفشل والهدر المدرسيين لدى العديد من التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التمدرس. هذا ما دفع التصورات الجديدة في التربية تركز على بعض الأبعاد الجديدة التي تجعل المتعلم فاعل في عملية التعلم، كما تراعي مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين. فما هي إذن البيداغوجيا الفارقية ؟ و كيف يمكن توظيفها ديداكتيكيا؟
مفهوم "البيداغوجيا الفارقية":
أول
من استخدم مفهوم "البيداغوجيا الفارقية" الفرنسي لوي لوغران
(Louis Legrand) سنة 1973، خلال تقديم مشروعه إلى وزارة
التربية الفرنسية للحد من مشكلات الفشل
والهدر الدراسيين. حيث تقر هذه البيداغوجيا بوجود فروق
فردية بين المتعلمين داخل نفس الفصل الدراسي تحول دون اكتسابهم للمعارف والمهارات
والقيم بنفس الطريقة ونفس الإيقاع، مما يستلزم ضرورة إتباع أساليب مختلفة تراعي
خصوصياتهم من أجل تحصيل نفس الأهداف.
تنطلق
البيداغوجيا الفارقية من وجود فروق فردية بين المتعلمين، وهي على العموم: فروق
معرفية على مستوى قدراتهم المعرفية وطرائق اكتساب المعارف واستراتيجيات
التعلم...؛ وفروق سيكولوجية تبعا لشخصياتهم وحاجاتهم وحافزيتهم...؛
وأخيرا فروق سوسيو- ثقافية تتجلى في اختلاف تمثلاتهم الناتجة
عن الانتماءات الاجتماعية والهويات الثقافية والقناعات الدينية والمذهبية وأنماط
التنشئة الاجتماعية...
الأسس النظرية للبيداغوجيا الفارقية:
ترتكز
البيداغوجيا الفارقية على نتائج البحوث والدراسات في علم النفس الفارقي في ارتباط
بعلم النفس التعلم الذي يهتم بدراسة الفروق الفردية بين الأفراد والجماعات؛ الفروق
البيولوجية والوجدانية والمعرفية والاجتماعية... ومنها الفروق الفردية في المجال المدرسي،
على مستوى النمو المعرفي، ووثيرة التعلم، والاستراتجيات المعتمدة فيه، وكذا
الحافزية للعمل الدراسي، وعلاقة المتعلم بالمدرسة... في
صلة وثيقة بعلم النفس التعلم الذي يدرس التعلم باختلاف طبيعته وخصائصه وشروطه بحسب
الأفراد.
خصائص البيداغوجيا الفارقية :
تتميز
البيداغوجيا الفارقية بالخصائص الآتية:
- بيداغوجيا
فردانية: التعامل مع المتعلم باعتباره فردا مختلفا باختلاف
أبعاد شخصيته (البيولوجية، المعرفية، النفسية، الاجتماعية...)؛
- بيداغوجيا
متنوعة: تُنوَّع من طرائق وتقنيات التدريس...؛
- بيداغوجيا متجددة: تُجدد أنشطة التعليم و تَنفتح على التغيير وتُساير المستجدات...
أهداف البيداغوجيا الفارقية:
- تنويع المحتويات والوسائل وأساليب التدريس والإيقاعات الزمنية...
- الحد من الفشل الدراسي (التعثر، الانقطاع، التكرار، الهدر...)؛
- التمييز الإيجابي بين المتعلّمين من أجل تفعيل مبدأ تكافؤ فرص
النّجاح بينهم؛
- الانطلاق من خلفية حقوقية (الحق في الاختلاف وقيمة التسامح...)؛
-
تطوير قدرة المتعلم على الثقة في النفس وتحمل المسؤولية والاستقلالية
والحافزية والتعلم الذاتي...؛
-
مساعدة المتعلم على الوعي باستعداداته وتطوير قدراته ومهاراته الخاصة...؛
-
مساعدة المتعلّمين على ممارسة التقييم الذاتي والمتبادل...
التوظيف الديداكتيكي للبيداغوجيا الفارقية:
يقتضي الوعي بالفروق الفردية بين المتعلمين تبعا
لهوياتهم واستعداداتهم وقدراتهم ومواقفهم وحوافزهم، باعتبارها تؤثر على كيفية
تعلمهم وكذا أسلوبهم في التعلم. مما يقتضي من المدرس الوعي بخصائص البيداغوجيا
الفارقية وأشكال توظيفها ديداكتيكيا.
الخطوات العملية لتطبيق البيداغوجيا الفارقية:
- تحديد أهداف التعلم بشكل عام؛
- التقييم التشخيصي لمكتسبات المتعلمين ذات الصلة
بالأهداف العامة باعتماد الروائز والاختبارات...؛
- تفييء المتعلمين إلى فئات متجانسة وفق درجة
تحقق الأهداف العامة إلى (متفوقين/متوسطين/ضعاف)؛
- بناء الوضعيات وانتقاء المحتويات والأنشطة
والوسائل المناسبة لكل فئة من المتعلمين؛
- تنويع طرائق التدريس المناسبة لكل فئة من
المتعلمين؛
- تقييم إنجازات كل فئة من المتعلمين على حدة، مع تسطير برامج للدعم والمعالجة.
إكراهات
تطبيق البيداغوجيا الفارقية :
- غياب التكوين أو عدم
كفايته في مجال البيداغوجيا الفارقية؛
- هيمنة البيداغوجيا التقليدية على مستوى
الممارسات تحول دون تطبيق البيداغوجيا الفارقية؛
- إشكالية الامتحان الموحد وطابعها الإداري
والجزائي لا تراعي الاختلافات الموضوعية.
- ضيق الحيز الزمني لإنجاز مقرر دراسي مكثف يَحُول
دون برمجة حصص إضافية للمتعثرين.
- عدم توفر الوسائل الديداكتيكية
الضرورية، والمعينات الإلكترونية، والحجرات الدراسية الملائمة، من أجل تطبيق نتائج
الفوارق بين المتعملين.
- غياب حرية التصرف للمدرس في تخطيط
وتدبير وتقويم الدروس بما يراعي الاختلافات بين المتعلمين.