مقاربة التدريس بالأهداف:
يعتبر زعيم مجموعة "شيكاغو" رالف تايلر (Ralph Tyler / 1902–1994)
أول من تحدث عن الأهداف التعليمية سنة 1935. وفي عام 1948 نظمت "الجمعية
الأمريكية للسيكولوجيا" في بوسطن بالولايات المتحدة مؤتمرا دوليا ناقشت فيه
أسباب الفشل الدراسي في المؤسسات التعليمية.
ومن بين أهم أسباب التعثر الدراسي للمتعلمين حسب المؤتمرين هو عدم
وضوح الأهداف التربوية للمدرسين بشكل عملي. وقد نتج عن هذا المؤتمر وضع مجموعة من
الصنافات (taxonomies)،
مثل صنافة بنيامين بلوم (/ 1913-1999 Benjamin Bloom)
التي عنونها بـ"تصنيف الأهداف التربوية، المجال العقلي المعرفي" ونشرها سنة 1956.
وأتبعها الجزء الثاني بعنوان "تصنيف الأهداف التربوية، المجال الانفعالي العاطفي" بإشراف
السيكولوجي الأمريكي دافيد كراثوول David
Krathwohl 1921-2016)).
وفي الستينيات والسبعينيات من القرن 20 انتشرت نظرية الأهداف في باقي
دول أوروبا. وتبنى المغرب رسميا هذه النظرية في الثمانينيات من نفس القرن. حيث كان
الغرض منها ترشيد الممارسات التعليمية -التعلمية تخطيطا وتدبيرا وتقويما، بترجمة الفلسفة التربوية إلى أهداف محددة تُمكن المدرسين من أداء مهامهم المهنية، كما تساعد
المهتمين بالشأن التربوي على تقويم المنظومة التعليمية.
الأسس النظرية لبيداغوجيا الأهداف: الاستعداد مباريات التعليم 2022-2023
ارتكزت بيداغوجيا الأهداف على ثلاثة أسس، هي: الفلسفة البرغماتية، النزعة التايلورية، النظرية السلوكية...
1-الفلسفة البرغماتية (Pragmatisme):
الفلسفة البرغماتية فلسفة أمريكية معاصرة تعطي الأولوية للجانب النفعي العملي على حساب الجانب النظري المجرد الذي يتأسس على التخمين والظن. ويتجلى البعد البرغماتي لمقاربة التدريس بالأهداف في تركيزه على النتائج البيداغوجية، وعلى مدى تحقق الأهداف التربوية وفائدتها العملية.
2-النزعة التايلورية (Taylorisme):
تنتسب النزعة التايلورية إلى فريدريك تايلور (Frederick Taylor) الذي دعا إلى تعزيز
مبادئ الفعالية والإنتاجية والعقلانية في الميدان الصناعي، عبر إجراءات منها:
تجزيء عملية الإنتاج إلى وحدات أو مهام صغرى دقيقة ومركزة بشكل يساهم في مضاعفة
الإنتاجية والمردودية.
وقد تم نقل مبادئ العقلانية والفاعلية والإنتاجية من القطاع الصناعي
المقاولاتي إلى مجالات أخرى غير صناعية كالتربية، حيث ترشيد الفعل التعليمي بكل ما
يقتضيه من تخطيط وتدبير وتقييم.
3-النظرية السلوكية (Behaviorisme):
تستمد بيداغوجيا الأهداف الكثير من أسسها الإبستمولوجية والعلمية من
النظرية السلوكية بوصفها نظرية في التعلم في إطار سيكولوجيا التربية. هذه النظرية
التي انطلقت في مطلع القرن 20، عندما قام الأمريكي جون واطسون بدراسة
السلوك الإنساني في ارتباطه بالبيئة. ومن أبرز ممثلي الاتجاه السلوكي، فضلا عن هذا
الأخير، نجد الأمريكييْن فريدريك سكينر، وإدوارد ثورندايك؛ ثم الطبيب
الروسي إيفان بافلوف.
سنركز على السلوكية لأهميتها في تشكيل الأسس النظرية والمرتكزات البيداغوجية لمقاربة التدريس بالأهداف، خاصة في ما يتعلق بإسهامات روادها في مجال "نظريات التعلم"، وإمكانات تطبيق هذه النظريات بيداغوجيا وديداكتيكيا.
أهم نظريات التعلم التي تقوم على بيذاغوجيا الهادف:
1- نظرية
التعلم عند إدوارد ثورندايك (Edward Thorndike)
(1874- 1949):
- قانون الاستعداد: يرتبط بقانون الحافزية، بمعنى أن الاستعداد
للتعلم يتقوى بالحوافز ويضعف بالعوائق؛
- قانون الأثر: يعني أن العمل المنجز يترك أثرا إيجابيا في
المتعلم (يحقق حاجاته ورغباته...)؛
- قانون الممارسة: يتحقق التعلم بالتدريب المستمر والممارسات المتكررة.
2-النظرية الترابطية (Connexionnisme):
التعلم هو نتاج الترابط أو العلاقة الشرطية بين المثير (stimilus) والاستجابة (réponse)، ومن ثم تتقوى عملية التعلم أو تضعف حسب قوة الترابط وضعفه؛ ذلك أن الترابط يتقوى إيجابيا بالتحسينات والمكافآت، ويضعف سلبيا بالعقاب. بمعنى أن جميع السلوكات قابلة للتعلم بواسطة عملية التشريط (conditionnement)، سواء كانت هذه السلوكات لغوية أو انفعالية أو حركية.
3-نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ:
تقوم نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ على المفاهيم الآتية:
-
التكرار: تكرار المحاولات يؤدي إلى بلوغ الهدف المنشود لأنه يقوي الروابط
بين المثير والاستجابة؛
- التعزيز: تشجيع المتعلم بالمكافأة بهدف تحقيق المبتغى؛
- الانطفاء: إذا لم يتحقق التعزيز، يقع الانطفاء، أي تراجع
المتعلم عن الاستجابة الفورية؛
- الاسترجاع التلقائي: بعد عملية الانطفاء، يمكن
للمتعلم أن يسترجع قواه بطريقة تلقائية؛
- التعميم: ما تعلمه المتعلم يمكن تعميمه في حل وضعيات متشابهة؛
- التمييز: فشل المتعلم في حل وضعية بناء على وضعية مشابهة،
يقتضي فك الارتباط بين الوضعيتين؛
- العلاقات الزمانية: كلما كانت الاستجابة فورية وفي مدة قصيرة كان التعلم ناجحا، وكلما طالت الفترة الزمنية ضعف التعلم والاكتساب.
4- نظرية التعلم عند جون واطسون (John Watson) (1878- 1958):
يعتبر واطسون أحد رواد النظرية السلوكية، انتقد أعمال ثورندايك مثل قانون الأثر وقانون نقل الارتباط ومفهوم الحافز، لكنه تأثر بنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، وعمل على تطويرها. اعتبر واطسون أن التعلم يخضع لقانونين أساسيين:
- قانون التدريب (المران / الممارسة)؛
-قانون الأثر.
5- نظرية
التعلم عند فريدريك سكينر (Frederic Skinner) (1904 -
1990):
التعلم حسب سكينر هو عملية تعديل
للسلوك بشكل متواصل، انطلاقا من استجابات سلوكية مرغوب فيها بفعل التشريط
الإجرائي. وترتبط نظرية التعلم عنده بمجموعة من المفاهيم، كالآتي:
-السلوك: هو استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي طبيعيا كان
أو اجتماعيا.
- المثير والاستجابة: العلاقة
بين المثير والاستجابة شبه ميكانيكية تصدر عن الكائن البشري.
- الإجراء: هو سلوك له آثار ملموسة في
الوسط الاجتماعي.
- التشريط الإجرائي: المثير
يفرز استجابة سلوكية.
- التعزيز والعقاب: التعزيز لبناء السلوكات المرغوب فيها، والعقاب لدرء السلوكات غير المقبولة.
6- نظرية
التعلم عند إيفان بافلوف (Ivan Pavlov) (1849 -
1963):
يعتبر بافلوف من مؤسسي المدرسة
السلوكية، لاحظ أنه كلما اقترن المثير الشرطي بالدافع السيكولوجي إلا وتكونت
الاستجابة الشرطية الانفعالية. ورأى بأن المثيرات الشرطية المنفرة تشكل عوائق
حاسمة للتعلم وانبناء الاستجابات النمطية.
خاتمة : تجاوز المقاربة بالأهداف لصالح المقاربة بالكفايات:
اعتبرت المقاربة بالأهداف، في فترات زمنية تاريخية، مقاربة بيداغوجية حديثة قائمة على الموضوعية والعقلانية والضبط والتخطيط، بديلا عن الدرس التقليدي التلقيني الذي يتأسس على مركزية المحتويات من معارف ومهارات وقيم محددة سلفا دون أن يشارك المتعلمون في بنائها.
حيث كان منظرو بيداغوجيا الأهداف، في البداية، يؤكدون على السلوكات القابلة للملاحظة والقياس. كما اعتبروها معيارا إجرائيا لتقييم المنظومة التعليمية على مستوى المردودية والإنتاجية. لكن عندما عجزوا عن ترجمة جميع الأهداف إلى سلوكات إجرائية يعتبرونها أساس بناء التعلمات، تحول اهتمامُهم إلى الحديث عن القدرات.
ومن ثم تحول اهتمام البيداغوجيين
إلى الحديث عن الأهداف العامة، والتي تعني القدرات والمهارات بلغة مقاربة التدريس
بالكفايات. قبل أن يبتكروا مقاربة جديدة تتأسس على نموذج بيداغوجي متمركز على
اكتساب المتعلمين للكفايات المنشودة، حيث اعتبرت هذه المقاربة أداة فعالة في مجال
إشراك المتعلمين في بناء تعلمات واضحة وناجعة.
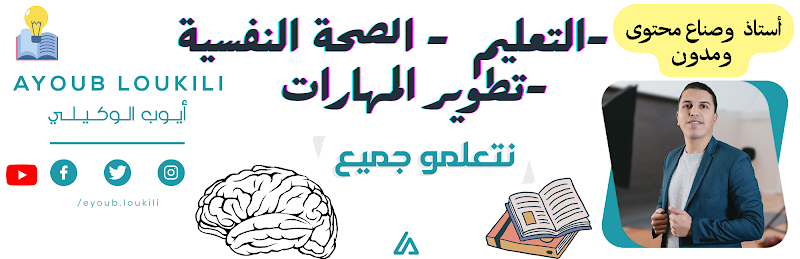

.png)