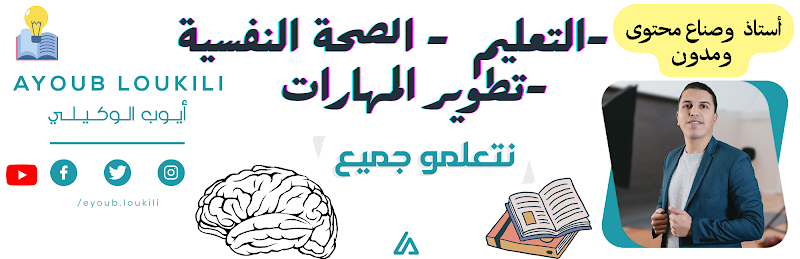بيداغوجيا المشروع (Pédagogie de
projet)
استلهمت "بيداغوجيا المشروع" من الأفكار البرغماتية
للفيلسوف الأمريكي جون ديوي (1859-1952)، على اعتبار أن المشروع التربوي
شأنه شأن أي مشروع هو نشاط موجه نحو تحقيق أهداف محددة.
خاصة عندما تستجيب هذه
الأهداف لحاجات واهتمامات المتعلمين. وقد سار عن نهجه أحد تلامذته وهو البيداغوجي
الأمريكي وليام هيرد كلباتريك (William Heard Kipatrick / 1871-1965)
حين اعتبر المشروع التربوي نشاطا عمليا ونفعيا يجعل المتعلمين يعيشون الحياة
المدرسية بشوق وارتياح.
ما هو المشروع التربوي؟
ترى هذه البيداغوجيا أن المشروع هو أساس التعلم الذي يقوم على البحث.
وهذا ما يتطلب من المتعلم استثمار جملة من الكفايات (قيم ومعارف وقدرات
ومهارات...). لهذه الاعتبارات ارتبطت "بيداغوجيا المشروع" بمقاربة
التدريس بالكفايات.
وقد أدرجه المنهاج الدراسي لمادة الفلسفة ضمن أنشطة المتعلمين التي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة؛ فردية أو ثنائية أو جماعية أو عبر مشاريع "تتوخى انفتاح التلميذ(ة) على مصادر المعرفة في أصولها ومراجعها وتنمية قدراته المنهجية وروح المبادرة والقدرة على الاختيار. ويكتسب مشروع البحث الشخصي قيمته ومعناه من خلال مشاركة التلاميذ في وضع المشاريع واختيارها وتنظيم العمل حولها"[1].
تعريف "بيداغوجيا المشروع":
بيداغوجيا
المشروع هي "طريقة تقوم على تقديم مشروعات للتلاميذ، في صيغة وضعيات تعليمية
تدور حول مشكلة اجتماعية واضحة، تجعل التلاميذ يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها حسب
قدرات كل منهم، وبتوجيه وإشراف المدرس، وذلك اعتمادا على ممارسة أنشطة ذاتية
متعددة في مجالات شتى."[2]
ويعتبر المشروع
البيداغوجي، حسب فليب بيرنو، بمثابة مقاولة جماعية تدبرها جماعة القسم
(التلاميذ) بتنشيط من المدرس. ويتوجه المشروع عموما نحو إنتاج ملموس (إنتاج أدبي
أو علمي، عمل فني، نشاط رياضي، احتفال...)، من خلاله يتم تعلم معارف ومهارات
مرتبطة بتدبير المشروع (اتخاذ القرار، التخطيط، التنسيق...)، وتعلمات أخرى ذات
الصلة بالبرنامج الدراسي المتعلق بالمادة التي يشرف مدرسها على التخطيط والتدبير
للمشروع، أو في علاقة بمواد دراسية أخرى، لأن طريقة المشروع تتجاوز الحدود الفاصلة
بين المواد الدراسية[3].
أنواع المشاريع التربوية:
- مشروع المتعلم:
ينجزه المتعلم، بشكل فردي أو جماعي، في إطار مادة دراسية
يشرفها عليها مدرس تلك المادة بهدف اكتساب القدرات والمهارات؛
- المشروع التربوي: يقترحه الفاعلون
في المؤسسة (تلاميذ ومدرسون وإداريون وممثلو جمعية الآباء..)؛
- المشروع البيداغوجي: يشرف عليه
فريق من المدرسين ينتمون إلى أقطاب متقاربة (قطب اللغات، قطب العلوم، قطب الآداب...)
وينصب على تحسين التعلمات في المواد المتآخية داخل هذه الأقطاب؛
- مشروع المؤسسة: ينجزه الفاعلون داخل المؤسسة مع شركائهم من خارجها للرفع من إنتاجية المؤسسة وتحسين شروط العمل بها.
الأهداف التربوية لبيداغوجيا المشروع:
حدد فليب بيرنو عشرة وظائف لبيداغوجيا المشروع نذكرها كاملة،
نظرا لأهميتها:.
- تعبئة المعارف والمهارات المكتسبة وبناء الكفايات.
- التعاطي مع الممارسات الاجتماعية التي تنمي المعارف والتعلمات
المدرسية.
- اكتشاف معارف وعوالم جديدة من منظور تحسيسي أو تحفيزي...
- إثارة تعلمات جديدة في إطار المشروع نفسه
- تحديد المكتسبات والنواقص في إطار منظور التقويم الذاتي وتقويم
الحصيلة
- تنمية التعاون والذكاء الجماعي...
- تكوين التلميذ على تصور وقيادة المشروع....
- تنمية الاستقلالية والقدرة على وضع الاختيارات والتفاوض بشأنها.[4]
ومن الأهداف التربوية العامة لبيداغوجيا المشروع، نذكر أيضا:
- تنمية أساليب التفكير العقلي والنقدي والعلمي في حل المشكلات؛
- تنمية الحس العملي التطبيقي المرتبط بالحياة الواقعية لدى
المتعلمين؛
- الثقة في النفس وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي التعاوني...؛
- اكتساب قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية...؛
- تحبيب التلاميذ في المدرسة ومكوناتها (الفضاءات والتجهيزات،
الفاعلين، المواد الدراسية...).
وقد أضاف مجموعة من المؤلفين المغاربة أهدافا أخرى، فضلا عما ذكر،
وتتجلى في:
- جعل المتعلم محور العملية التعليمية -
التعلمية (المقاربة التشاركية)؛
- مراعاة ميول المتعلمين وقدراتهم؛
- تأسيس التعلم على النشاط الذاتي
للمتعلمين؛
- انفتاح المدرسة على المحيط الاجتماعي؛
- التدريب على التخطيط والتنظيم و
القدرة على جمع المعلومات والبيانات وتوظيفها...[5]
مراحل وخطوات بيداغوجيا المشروع: المرحلة الأولى: اختيار الموضوع
- اختيار الموضوع من طرف المتعلمين أنفسهم انطلاقا من حاجاتهم
ورغباتهم وتطلعاتهم الخاصة؛
- اختيار موضوع مفيد وعملي (يعبر عن مشكلة تربوية ملحة، يخدم مصلحة
المتعلم والمؤسسة، يرتبط بالمقرر الدراسي لمادة أو مجموعة من المواد...)؛
* المرحلة الثانية: تخطيط المشروع
- تحديد الأهداف، وضع خطة محددة ومضبوطة بشكل جماعي، حصر الوسائل
والموارد والإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية، تحديد المهام والمتدخلين،
تحديد الغلاف الزمني...؛
* المرحلة الثالثة: تنفيذ المشروع
- تنفيذ المشروع وفق الأهداف والخطة والإمكانات والآجال...؛
* المرحلة الرابعة: تقويم المشروع
- مناقشة إنجازات المتعلمين (تحديد مواطن القوة والضعف)؛
- تتبع التنفيذ،
تحليل النتائج، تحليل الاستراتيجيات المعتمدة، جودة المنتوج...
- تقييم مدى
نجاعة التخطيط والتدبير [6].
هكذا تشكل "بيداغوجيا المشروع" إحدى المقاربات البيداغوجية التي
يعتمدها التدريس بالكفايات، عندما تركز هذه البيداغوجيا على طريقة حل المشكلات في
سياق وضعيات حقيقية أو مصطنعة (ديداكتيكية). وما يقتضيه ذلك من تحديد المشكلة
واقتراح الفرضيات لحلها بشكل عملي تطبيقي. فضلا عن كون هذه بيداغوجيا تساعد
التلاميذ على التعلم الذاتي والتعلم المتبادل (التعلم بالنظير)، ومراعاة مبدأ
الفروق الفردية. فعدم اعتبار هذه المبادئ يجعل طريقة المشروع تنحرف عن أهدافها
الحقيقية.
[1] وزارة التربية الوطنية، التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة
بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، 2007، الرباط، ص12
[3]
Philippe Perrenoud, Apprendre à l’école
à travers des projets : pourquoi ? Comment ?, 1999
مقالة لفليب برينو نُشرت في موقع جامعة جنيف،
كلية علم النفس وعلوم التربية، بتاريخ 1999,