مبادئ مقاربة التدريس بالكفايات :
مبدأ مركزية المتعلم: المتعلم
هو الفاعل، مراعاة الأبعاد المختلفة لشخصيته، الانطلاق من واقعه وحاجاته.
مبدأ التشارك: يساهم المتعلم
في بناء تعلماته بتوجيه من المدرس.
مبدأ التعلم الذاتي:
الانتقال من التعليم إلى التعلم، مع التوجه نحو التعلم الذاتي مدى الحياة.
مبدأ الفروق الفردية: مراعاة
الفروق الفردية بين المتعلمين على المستوى المعرفي والنفسي والاجتماعي.
مبدأ الحرية: حرية المدرس
ومبادرات المتعلم في بناء التعلمات.
مبدأ الإبداعية: دفع المتعلم
إلى الابتكار بدل محاكاة نماذج جاهزة.
مبدأ الوضوح: للتعلمات معنى؛
مبدأ النفعية: للتعلمات فائدة.
خصائص "مقاربة التدريس بالكفايات:
خاصية التطبيق: يكتسب المتعلم
الكفايات انطلاقا من ممارساته العملية؛
خاصية التكرار: تكليف المتعلم
بنفس المهام من أجل اكتساب الكفايات؛
خاصية الاستمرارية: ما تعلمه
المتعلم في وضعيات محددة يبقى أثره مع مرور الزمن؛
خاصية التطور: الكفاية معطى
متغير، تنمو وتتطور، وقد تتراجع، لكنها تُكتسب بعد مسارات تكوينية؛
خاصية الترابط: الربط بين
الأنشطة وبين المواد المختلفة وبين التعلمات السابقة واللاحقة في تنمية الكفاية؛
خاصية التكامل: التكامل بين مختلف المواد والوحدات الدراسية في بناء الكفايات، خاصة
المستعرضة منها؛
خاصية القابلية للنقل (transférable): نقل الكفايات النوعية
من مادة إلى مواد أخرى لتصير ممتدة؛
خاصية القابلية للتقويم: (Evaluabilité) قابلية الكفاية للتقويم
التكويني أو الإجمالي.
خاصية الاستثمار: استثمار المتعلم للتعلمات السابقة مما يؤشر على اكتساب الكفايات المنشودة.
أنواع الكفايات:
تبنى النظام التربوي المغربي المعاصر مدخل الكفايات بشكل صريح مع صدور
"الميثاق الوطني للتربية والتكوين" (يناير 2000). حيث تم اعتبار هذا
المدخل اختيارا تربويا. ولأجرأة هذا التوجه انكبت لجنة
الاختيارات والتوجهات التربوية في "الوثيقة الإطار لمراجعة المناهج التربوية
وبرامج تكوين الأطر" (مارس 2002) على ضبط أنواع الكفايات، حيث صنفتها إلى
كفايات نوعية خاصة بكل مادة على حدة؛ وكفايات ممتدة حصرتها في خمسة أنواع. وهي
الكفايات الإستراتيجية والكفايات التواصلية والكفايات المنهجية والكفايات الثقافية
والكفايات التكنولوجية [1].
هذه الكفايات الخمسة الأخيرة
اعتبرتها وثيقة المنهاج الدراسي لمادة الفلسفة بالتعليم الثانوي[2]،
بمثابة كفايات نوعية عندما يتم ربطها بمقتضيات تخص هذه المادة بعينها. كما تناول بعض
البيداغوجيين أنواعا أخرى من الكفايات، ومنها الكفايات القاعدية وكفايات الإتقان.
الكفايات الممتدة (المستعرضة): (Compétences transversales)
عندما تكون الكفايات النوعية قابلة للنقل (transférable) والانفتاح على مواد
وتخصصات دراسية مختلفة تصبح ممتدة، أي عامة ومشتركة. ومنها:
- امتلاك مبادئ التفكير النقدي في
مختلف أبعاده؛
- التواصل بكل أشكاله (قراءة، كتابة، مناقشة..)؛
- امتلاك أخلاقيات الحوار ومبادئه
وأشكاله؛
- توظيف التكنولوجيات الحديثة للحصول
على المعلومات ومعالجتها؛
- امتلاك ثقافة تكوينية عقلية ومتفتحة ومواطنة [3].
الكفايات النوعية (الخاصة) (Compétences disciplinaires spéciales):
الكفايات النوعية هي كفايات خاصة ترتبط بمادة دراسية معينة،
معرفيا ومنهجيا وقيميا... وبالتالي تكون أقل شمولية وعمومية. والأمر هنا يتعلق
بمادة الفلسفة. لهذا اعتبرها المنهاج الدراسي لمادة الفلسفة كفايات نوعية، كما
سبقت الإشارة إلى ذلك. وهي كالآتي:
كفايات إستراتيجية[4]:
كفايات إستراتيجية من خلال تنمية قدرات مرتبطة بالذات:
- القدرة على الوعي بالذات؛ القدرة على تقدير الذات؛ القدرة على
التموقع في الزمان والمكان؛
- القدرة على الاستقلال الذاتي والمبادرة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية
بشكل إرادي؛
- القدرة على ممارسة التفكير والتعبير عن المواقف والتحكم الواعي في
الاختيارات والقرارات...
كفايات إستراتيجية من خلال تنمية قدرات في علاقة الذات مع الآخر والمجتمع:
- القدرة على إقامة علاقة إيجابية مع
الغير أساسها الانفتاح والاحترام والتسامح والتضامن والحوار...؛
- القدرة على الحفاظ على كرامة
الإنسان وصيانتها؛
- القدرة على التموقع بالنسبة للمجتمع ومؤسساته المختلفة؛
- القدرة على النهوض بالواجبات
والمسؤوليات الناجمة عن العيش المشترك والعمل داخل الجماعة؛
- القدرة على تعديل الاتجاهات
والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة والثقافة والمجتمع...
كفايات تواصلية:
- القدرة على الإنصات، والتواصل مع
الآخر (كاتب(ة)، أستاذ(ة)، تلميذ(ة)...)؛
- القدرة على الأداء اللغوي الفلسفي
السليم؛
- القدرة على التعبير الشفهي والحوار
بلغة فلسفية واضحة ودقيقة في وضعيات تواصلية؛
- القدرة على القراءة الفلسفية لنصوص
فلسفية؛
- القدرة على إنتاج كلام أو تعبير
يراعي خصوصيات القول الفلسفي؛
- القدرة على إنتاج كتابة فلسفية
منظمة أو موضوع فلسفي في وضعيات تقويمية وإنتاجات إبداعية.
كفايات منهجية:
- القدرة على التعبير الشفوي ضمن وضعيات حوارية
أفقية وعمودية؛
- القدرة على التعبير الكتابي عبر ضبط مستلزمات
الكتابة الفلسفية المدرسية؛
- القدرة على التعبير الشفوي والكتابي ضمن
سيرورات العمل الفردي والجماعي...؛
- القدرة على وضع خطط لمعالجة إشكالات فلسفية
نظرية وقضايا واقعية متصلة بالحياة المجتمعية؛
- القدرة على تنظيم المعطيات (معلومات، معارف، موارد...) في خطاطات لمواجهة وضعيات- مشكلة.
لقدرة على اكتساب الأدوات المنهجية للتفكير الفلسفي ضمن سيرورات المفهمة والأشكلة والمحاججة؛
- القدرة على اكتساب أدوات التفكير الأخرى (الملاحظة، المقارنة، الاستدلال، التحليل، التركيب، النقد...)؛
- القدرة على تحقيق التماسك المنطقي في التعبير والكتابة عن طريق التحكم في أدوات الربط المنطقي؛
- القدرة على الإخراج الجيد للمنتوجات والمدخلات (الأسلوب، الخط، الترتيب، الدقة، الوضوح...إلخ)؛
- القدرة على اكتساب منهجية العمل داخل الفصل
وخارجه؛
- القدرة على العمل والتفكير بتحديد الأهداف
والوسائل وتحديد خطوات الإنجاز؛
- القدرة على التكوين الذاتي، وتدبير المشاريع الشخصية...؛
- القدرة على تدبير الوقت وتنظيم الشؤون الخاصة.
كفايات ثقافية:
- القدرة على التشبع وجدانيا بالقيم الإنسانية التي يروج لها الدرس
الفلسفي؛
- القدرة على ترسيخ الهوية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى؛
- القدرة على اكتساب معرفة فلسفية وفهمها
واستيعابها؛
- القدرة على وضع تلك المعرفة في
سياقها النظري؛
- القدرة على وضع تلك المعرفة في
سياقها التاريخي والثقافي العام؛
- القدرة على تنويع وتوسيع مصادر
المعرفة الفلسفية في تعددها؛
- القدرة على استدعاء معارف متنوعة رافدة للتفكير الفلسفي (أدبية، فنية، علمية، سياسية...)؛
ك كفايات تكنولوجية:
- القدرة على استخدام تقنيات التواصل
الحديثة في مجال التفكير الفلسفي (استغلال الأنترنيت...)؛
- القدرة على استغلال إمكانات
التقنيات الجديدة للتواصل من خلال الكتابة والنشر في مجال الفلسفة؛
- القدرة على
استعمال الوسائط والدعامات التكنولوجية في اكتساب المعرفة الفلسفية داخل الفصل
وخارجه.
كفايات نوعية أخرى مرتبطة بمادة الفلسفة:
تشير الكفايات النوعية لمادة الفلسفة إلى مجموع القدرات والمهارات
التي يكتسبها المتعلم وينميها في الدرس الفلسفي. ومن القدرات الأساسية للتفلسف:
الأشكلة، المفهمة، المحاججة؛ أما المهارات الأساسية للفلسفة فتشير إلى القراءة
الفلسفية، المناقشة الفلسفية، الكتابة الفلسفية[5].
الكفايات القاعدية:
كفايات أساسية وضرورية تنبني عليها العمليات التعليمية – التعلمية.
مثال: كفايات القراءة
والكتابة...؛ كفايات التعبير الكتابي والشفهي...
كفايات الإتقان:
كفايات تكميلية، كفايات الجودة ليست أساسية وضرورية في
مستوى معين، ولكن قد تكون كذلك لاحقا.
بقي أن نشير أنه مهما كان نوع الكفاية المستهدفة، فإن أجرأتها تتم عن
طريق تحويلها إلى قدرات ومهارات...
التوظيف البيداغوجي لـ "مقاربة التدريس بالكفايات":
تهدف "مقاربة التدريس بالكفايات" بوصفها مقاربة بيداغوجية
وديداكتيكية إلى إكساب المتعلمين مجموعة من الكفايات ضمن وضعيات ديداكتيكية تطرح مشكلات يقتضي من هؤلاء المتعلمين إيجاد
حلول لها انطلاقا من مواردهم الخاصة (معارف، مهارات، قدرات، قيم...) وموارد زملائهم
والوسط المدرسي... وهي وضعيات مصطنعة شبيهة بوضعيات قد يصادفونها في حياتهم
الدراسية أو الواقعية.
إذ لا يمكن تصور الكفايات
بدون وضعيات، لأنها هي التي تجعل من الكفاية وظيفة لا سلوكا (بيداغوجيا الأهداف)
أو مضامين (البيداغوجيا المضامينية). ويتم التركيز ضمن مقاربة التدريس بالكفايات
على بيداغوجيا حل المشكلات، طالما أن الحياة سلسلة متصلة من المشكلات التي
تواجه الإنسان، يتحتم عليه حلها.
ليس
المطلوب من مدرس الفلسفة أن يفهم فقط المقصود بمقاربة التدريس بالكفايات، وأن يعرف
الكفايات المستهدفة في مادة الفلسفة. ولكن المتعين هو أن يوضح بشكل كبير كيف يمكن
للتلاميذ اكتساب تلك الكفايات في درس الفلسفة.
كيف يمكن للتلاميذ تعبئة مواردهم الداخلية (معارف، خبرات...) والخارجية (الزملاء، الوسط المدرسي، الوسائط الإلكترونية...) بغرض تطوير تلك الكفايات، ومعرفة الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك من أجل العمل على تجاوزها.
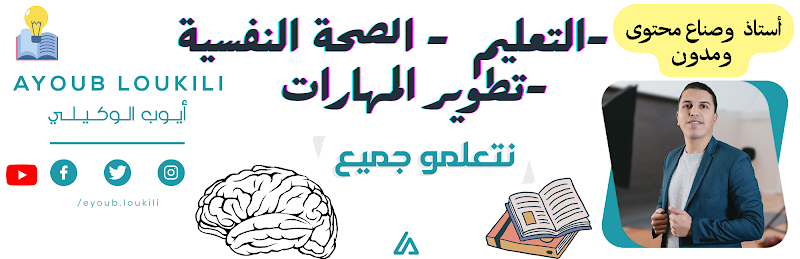

.png)