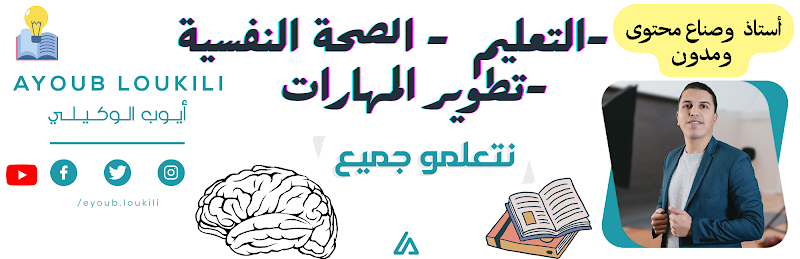خصائص النمو المعرفي ومتطلباته في مرحلة التمدرس:
إن سن السابعة في نظر بعض السيكولوجين هي سن النقد الذاتي وسن بداية التعليل قبل القبول أو النفي. والتفسيرات التي يقدمها الطفل للأشياء، لم تعد تفسيرات تطابق رغباته وإنما تفسيرات تحتكم إلى الواقع. حيث يصبح تفكير الطفل منذ بداية هذه المرحلة قادرا على تجاوز المحسوس المباشر، والظواهر التي يلاحظ تؤخذ في كليتها وترتبط فيما بينها بنسق من العلاقات التي تتيح تصحيح الحدس الحمي الذي كان يؤخذ من قبل كأنه شيء مطلق.
يصبح الطفل قادرا على استخدام قابلية الحدس كإوالية ذهنية. وضبط مفهوم الاحتفاظ بالوزن والجسم. وكذلك مفاهيم التعدي transitivité. والتمييز بين الجزء والكل والعلاقة بينهما.
أطفال هذه السن يحبون الكلام وهم شغفون بالتسميع سواء عرفوا الجواب الصحيح أم لم يعرفوه. باكتشاف الأطفال قوة الكلمات يجربون اللغة البذيئة أو السوقية ويحاولون إثبات دواتهم عبرها.
مفهوم النمو النمو يسير من العام إلى الخاص:
مثلا في النمو الحركي
يكون الشكل الأول هو الحركات العشوائية التلقائية وبنمو العضلات يصبح الطفل قادرا
على الجلوس والمشي وتصبح حركاته خاصة لها أهداف محددة ومقصودة. كذلك في النمو
اللغوي تحل الكلمة محل الجملة في الأول، ثم يبدأ بتركيب الكلمات وتكوين الجمل.
لهذا يعتبر النمو
عملية معقدة النمو تتفاعل فيها كل الجوانب: لا يمكننا دراسة
النمو من ناحية واحدة، فالنمو الجسمي يؤثر في النمو العقلي، وإذا أردنا أن نحسن
تنشئة الطفل فعلينا أن نعتني بجميع مظاهر النمو جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية.
العوامل المؤثرة في النمو
1-الوراثة:
تقوم العوامل
الوراثية بتحديد خصائص الكائن الإنساني البنائية والنوعية بحيث يشارك أفراد نوعه
في جملة من الخصائص ويتميز عنهم في الوقت نفسه. والعوامل الوراثية كذلك هي
المسؤولة عن بعض الأمراض التي يصاب بها الشخص، وتنتقل العوامل الوراثية عن طريق
الكروموزمات التي يبلغ عددها 46 كروموزوما. ويحصل الكائن الإنساني من خلال تكونه
على 23 كروموزوما من أبيه ومثلها من
ومن الخصائص التي تعتبر الوراثة مسؤولة عنها الصفات الجسمية لدى الفرد كلون العينين والشعر وشكل الأنف والطول والوزن، وغير خاف أن هناك بعض الاضطرابات العقلية التي تعتبر الوراثة مسؤولة عنها، كما هو الحال في الاعاقة الذهنية التي تعرف بالمنغولية الناتجة عن اتحاد ثلاثة كروموزومات بدلا من اثنين في الزوج الحادي والعشرين، ويلاحظ أن الشخص يتوفر على 47 كروموزما عوض 46.
البيئة
Ø إن الحاجات المتوفرة لأبناء الميسورين غير متوفرة
لأبناء الفقراء والأقل حظا مما يكون له انعكاس ليس فقط على جوانب التغذية والتعليم
والرحلات التي توسع المدارك المعرفية وتقوي القدرات العقلية وإنما أيضا على جانب
العلاقات الإنسانية ونوع الناس الذين يحتك معهم الطفل اجتماعيا وينشئ من خلال
تفاعله معهم نظاما لغويا.
Ø موقع الطفل وترتيبه بين إخوته: يختلف نمو الطفل
بحسب ما إذا كان طفلا وحيدا في الأسرة أو طفلا له إخوة، كما يتأثر نموه بحسب ما
إذا كان ترتيبه بين إخوته الأول أو الثاني أو الثالث (...) كما أن العلاقة بين
الإخوة فيما بينهم ليست سوى إعادة لتلك الأدوار التي سيقومون بها في المجتمع
الكبير عندما يندمجون في أدواره.
Ø طبيعة التنشئة الاجتماعية:
إن أسلوب تعامل الوالدين مع الطفل وطريقة تنشئته له دور كبير في نموه وتطوره على
صعيد الشخصية بوجه عام، فنضج شخصية الوالدين يؤدي إلى التعامل السوي والمتزن مع
الطفل وخلق الظروف الملائمة لنموه في حين أن الطفل الذي يعيش في جو يحس فيه بالنبذ
والرفض يشعر بعدم الأمن والوحدة فينشأ وهو غير قادر على تبادل العواطف ويميل إلى
جذب انتباه غيره (...) .
وهكذا فأساس كل أسلوب من أساليب التنشئة الاجتماعية يلعب دورا مختلفا في تطور الطفل وتكوين شخصيته وإكسابه أساليب وآليات سلوكية دفاعية مختلفة في الحياة.
أطفال المدرسة الابتدائية محبون للاستطلاع متباهون بمعرفتهم
وهم في نفس الوقت سريعو الانتقال من ميل إلى آخر.
هناك
فروق بين الجنسين في القدرات الخاصة وفي الأداء المدرسي. حيث تتفوق البنات في
الطلاقة اللفظية والقراءة، أما الذكور فيتفوقون في الاستدلال الرياضي وما يتطلب
علاقات مكانية واستبصارا. ومؤقتا تحصل الفتيات على الدرجات الأعلى في المدرسة
وربما ذلك ناتج عن رغبتهن في إرضاء الآخرين، في حين يميل الذكور الى القيام
بالأعمال التي تثير اهتمامهم.
خصائص النمو الانفعالي ومتطلباته في مرحلة التمدرس
6 - 12 سنة: تعرف هذه المرحلة طبيعة
انفعالية هادئة نسبيا، وذلك لدخول الطفل - حسب التحليل النفسي - في مرحلة الكمون
مما يوفر ويخزن طاقته العاطفية والجنسية استعدادا لظهورها في مرحلة البلوغ
والمراهقة . بالإضافة إلى الطاقة العاطفية والشحنات الانفعالية التي كانت تتمركز
حول الأبوين والتي أصبحت تجد لها موضوعات أخرى تستثمرها خارج إطار الأسرة .
يؤدي
نمو الضمير أو الأنا الأعلى إلى خلق عالم المراقبة والشعور بالذنب لدى الطفل وذلك
من جراء تشريبه للأوامر والنواهي الاجتماعية. باعتبارها مؤشرا على وجود المراقبة
الذاتية وبداية وظيفتها.
يصبح
أطفال هذا العمر يقظين ومتنهين لمشاعر الآخرين. كما يكونون حساسين للنقد والسخرية،
ويجدون صعوبة في التوافق بإدخال السرور على الراشدين ويحبون أن يساعدوا، ويستمتعون
بالمسؤولية.
تكون الاضطرابات السلوكية في قمتها في الصفوف الأخيرة من المدرسة الابتدائية. والأولاد أكثر مشكلات من البنات. وتفسر هذه الظاهرة في ضوء الضغوط الأسرية والتفاوت في التسامح مع السلوك عند الأطفال من طرف الراشدين. ومن المشكلات الشائعة بين الجنسين والتي كشفت عنها البحوث: الغيرة - النشاط الزائد - الرغبة في إثارة الاهتمام - التنافس والوشاية والكذب والنوبات المزاجية والسرقة.