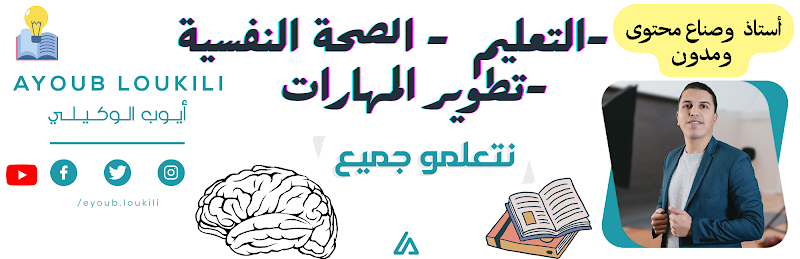أهم المفاهيم في علوم التربية:
الكفاية هي تتويج
الفترة طويلة من التعلم، وليست حصيلة حصة دراسية أو حصتين، ولذلك يعتبرها البعض
محطة ختامية لسلك تعليمي أو مرحلة تعليمية، وهذا ما يطرح إشكالية حول هذا المفهوم،
لأنه لا يمكن الإحاطة بمدلول الكفاية إلا من خلال تقديم نماذج من التعاريف
المتكاملة، قصد استنباط ما يجمع بينها جوهريا، لنوضح المعنى ونزيل الإشكال خاصة
بعد استحضارنا لتطور مفهوم الكفاية في مختلف المجالات المقاولة، علم الاجتماع، علم
النفس..
تعريف مفهوم الكفاية:
في هذا
السياق يشير د. محمد الدريج في مستهل تقديمه لتعريف الكفايات أنها
"قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين، ويتكون محتواها من معارف
ومهارات وقدرات واتجاهات مندمجة بشكل مرکب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها، بإثارها
وتجنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحلها في وضعية محددة"[1] .
وهي كذلك "نظام من المعارف المفاهيمية
والمنهجية الإجرائية والتي تكون منتظمة في خطاطات عملية تمكن داخل فئة من الوضعيات
من التعرف على المهمة المشكلة وحلها بطريقة فعالة"[2]، بهذا المعنى فإن الكفاية هي
القدرة على الفعل بنجاعة في بعض الوضعيات، التي تتطلب منا إدماج جملة من المعارف
والخبرات من أجل التعامل مع هذه الوضعية.
لهذا
فإنها تستخدم وتدمج وتعبئ معارف إعلانية وإجرائية وشرطية، تمكن الفرد من تعبئة
مجموعة من الموارد بهدف حل وضعية أو تحدي في الحياة اليومية، كما أنها تكون قابلة
للملاحظة انطلاقا من سلوكيات فعالة ضمن النشاط الذي ترتبط به.
الفرق بين الكفاية والهدف؟
نستنتج من
هنا أن الكفاية أشمل من الهدف الإجرائي في صورته السلوكية، لأنها تمثل نظاما ونسقا
منسجما من الأنشطة التي يقوم بها المتعلم قصد إنتاج أفعال أو سلوكيات، لحل وضعية
مشكلة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة اليومية، بهذا المعنى فإن الكفاية استعداد
الفرد لإدماج وتوظيف مكتسباته السابقة قصد حل وضعية-مشكلة أو التكيف مع وضعية
جديدة.
أنواع الكفايات:
1-
نوعية أو
الخاصة:
وهي كفايات ذات طبيعة عمومية ترتبط
بنوع محدد من المهام، أي بمادة دراسية معينة أو مجال نوعي أو مهني محدد، وهي أقل
شمولية من الكفايات المستعرضة، وقد تكون سبيلا إلى تحقيقها.[3]
2-
الكفايات
المستعرضة:
ذات طبيعة أفقية، وتسمى أيضا
الكفايات الممتدة، ويقصد بها الكفايات العامة التي ترتبط بمجال استعمال واسع دون
التقيد بمجال محدد أو مادة دراسية معينة، وإنما يمتد توظيفها إلى مجالات عدة أو
مواد مختلفة.
ويعرفها
كزافيي روجيرس ومن معه بقولهم: "نقصد بالكفاية الممتدة المعرفية، مجموعة
منظمة من الدرايات المعرفية والميتامعرفية (المعارف والخبرات وحسن التواجد التي
تمكن التلميذ من حل المشكلات وإنجاز المشاريع ومن التكيف داخل فئة من الوضعيات) "[4]
تعريف : للمفهوم الكفاية Philippe
PERRENOUD
يعرف بيرونو الكفاية بأنها القدرة على الفعل بنجاعة داخل فئة محددة من
الوضعيات، قدرة تستند إلى معارف لكنها لا تنحصر فيها (...) الكفايات ليست في حد
ذاتها معارف، إنها تستخدم وتدمج وتعبئ معارف إعلانية وإجرائية وشرطية " وقد
أشار في مؤلف آخر إلى أن الكفاية هي "قدرة الشخص على تعبئة موارد معرفية
مختلفة لمواجهة نوع محدد من الوضعيات". [5]
المهارة (Habilité):
يقصد بالمهارة، التمكن من
أداء مهمة محددة بشكل دقيق يتسم بالتناسق والنجاعة والثبات النسبي، ولذلك يتم
الحديث عن التمهير، أي إعداد الفرد لأداء مهام تتسم بدقة متناهية. أما الكفاية فهي
مجموعة من المهارات."[6]
مفهوم القدرة في التربية: القدرة (Capacité):
تدل على إمكانية أداء
نشاط معين، فهي وجود بالفعل بتعبير الفلاسفة. كما تشير إلى القوة على أداء فعل ما،
جسديا كان أو عقليا، وسواء كان هذا الفعل فطريا أو مكتسبا. ويفيد لفظ القدرة عدة
معان منها: التمكن الاستعداد والأهلية للفعل.. ويعرف فيليب ميريو "القدرة
باعتبارها نشاطا ذهنيا مثبتا و قابلا للتناسل في مجالات معرفية متعددة . ويستعمل
هذا المصطلح كمرادف لمعرفة العمل savoir faire. ويؤكد میريو في تعريفه على أن القدرة لا توجد أبدا في وضع خالص
ويكون تظهرها دوما مرتبطا بمحتويات."[07] أما من حيث العلاقة بين المهارة والقدرة،
فالمهارة أكثر تخصيصا من "القدرة" وذلك لأن المهارة" تتمحور حول
فعل يسهل ملاحظته خلال الممارسة والتطبيق، أما القدرة فترتبط بامتداد المعارف
والمهارات.
ما هو الاستعداد المدرسي؟ الاستعاد (Aptitude):
الاستعداد قدرة ممكنة، أي
وجود بالقوة، فهي "مجموعات من الصفات الداخلية التي تجعل الفرد قابلا
للاستجابة بطريقة معينة وقصدية، أي أن الاستعداد هو تأهيل الفرد لأداء معين بناء
على مكتسبات سابقة منها القدرة على الإنجاز والمهارة في الأداء. ولذلك يعتبر
الاستعداد دافعا للإنجاز لأنه الوجه الخفي له. وتضاف إلى الشروط المعرفية
والمهارية شروط أخرى سيكولوجية، فالميل والرغبة أساسيان لحدوث الاستعداد."[08]
الإدماج (Intégration): بيداغوجيا الإدماج: المفهوم والأهداف
يشير الإدماج، إلى سيرورة يطعم المتعلم من خلالها مكتسباته السابقة بتعلمات جديدة، ويعيد، بذلك، بناء عالمه الداخلي، ويطبق على وضعيات جديدة ومحسوسة المعارف المكتسبة.
اليك أهم المراجع المعتمدة في التحضير و الاستعداد لمباراة التعليم 2022-2021
اليك أهم المراجع المعتمدة في التحضير و الاستعداد لمباراة التعليم 2022-2021 |
[1] محمد الدريج، الكفايات في التعليم،
من أجل تأسيس علمي للمنهاج المندمج، الطبعة الأولى 2003، ص16.
[2] عبد الرحمن التومی/ د. محمد ملوك
المقاربة بالكفايات بناء وتخطيط التعلمات، الطبعة الأولى 2006
[3] د. محمد الدريج، الكفايات في
التعليم، من أجل تأسيس علمي للمنهاج المندمج، الطبعة الأولى 2003، ص45-
[4] كزافيي روجيرس ومن معه، بيداغوجيا
الإدماج: الإطار النظرية الوضعيات، الأنشطة، ترجمة: لحسن بوتكلاوي، الطبعة الأولى
2005،
[5] عبد الرحمن التومي وذ، محمد ملوك،
المقاربة بالكفايات: بناء المناهج وتخطيط التعلمات، الطبعة الأولى 2006:ص 29.
[06] مجموعة من الأساتذة، بيداغوجيا
الكفايات: مصوغة تكوينية، المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والشباب، بی ت
و ط2003، ص 10
[07] د. عبد الرحمن التومي وذ،
محمد ملوك، المقاربة بالكفايات: بناء المناهج وتخطيط التعلمات، الطبعة الأولى
2006: ص 29
[08] مجموعة من الأساتذة،
بيداغوجيا الكفايات: مصوغة تكوينية المملكة المغربية وزارة التربية الون بنية
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب، مديرية المناهج "2003، ص10