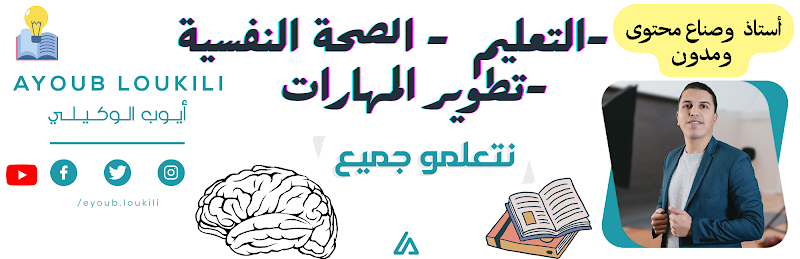ما هي العلاقة التي قد تربطني بالغير؟
1مطلب الفهم:
يثير السؤال الذي بين أيدينا موضوع العلاقة مع الغير، وهو موضوع يرتبط
بالوجود الإنساني، باعتباره وجودا اجتماعيا؛ تواصليا أي وجودا مشتركا مع الأغيار، وبذلك فهو وجود علائقي،
يحتاج إلى التفاعل والحوار والتواصل بين الذاوت، وهو ما يضفي عليه طابعا إنسانيا
بالحقيقة.
وبهذا المعنى فإن الأخرين، ليسوا شيئا بين الأشياء، القابلة للاستعمال، أو حيوانات قابلة للاستغلال، بل إن الأغيار ذوات تتميز بالاستقلال والحرية، يحملون وعيا وحرية وكرامة، توجب لهم قيمة، وهو ما يجعل العلاقة معهم تختلف عن أنماط العلاقات التي تكونها الذات مع الأشياء، الشيء الذي طرح مشكلة العلاقة بين الذات والغير، التي تحمل أبعاد مختلفة وجودية ومعرفية وأخلاقية ووجدانية، الشيء الذي يدفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات: أي علاقة يمكن أن تربط بين الذات والغير؟ هل هي علاقة الصداقة والوئام والاحترام أم علاقة الصراع والخصام والهيمنة؟
2-مطلب التحليل :
إن الإجابة عن
التساؤل قيد التحليل يحتاج منا بداية ضبطا لمفاهيمه، وأهمها المفهوم المركب "العلاقة
مع الغير"، إذ قد يبدو لعامة الناس أنها مسألة سهلة التناول،
فيكفي القول إن علاقتنا بغيرنا متعددة، الأبعاد فهو الصديق والعدو، وهو الزميل في
العمل أو المدرسة، والمنافس في التجارة والمجال الإقتصادي عموما، وهو الحبيب
والمعشوق في مجال المشاعر، أو العدو والخصم والمنافس في المجال الحربي والسياسي
والرياضي.
إن العلاقة مع الغير، إذن ليست بالإشكالية البسيطة، لأنها ترتبط بالغير كشرط في تشكيل ما يسمى بالوضع البشري. غير إن مفهوم الغير لم يظهر باعتباره إشكالية فلسفية إلا في الفلسفة الحديثة مع هيغل، بعد أن ظهر مفهوم الذات مع ديكارت، فبعد أن أبعد هذا الأخير – ديكارت- مفهوم الغير من فلسفته باعتبار الوعي بالذات ممكن بمعزل عن الآخرين، سيعيده هيغل باعتباره شرطا لوعي الذات على نحو مكتمل.
وهكذا ستصبح
العلاقة مع الغير معرفيا، علاقة لزوم، لأنه شرط في تحقق كمال وعي الذات بنفسها، لا
تقوم على معطى سلمي أو ودي أو على الشفقة والرأفة، بل ترتكز على الهيمنة والصراع.
إذن فإن العلاقة
مع الغير تقوم على الصراع والهيمنة، حيث يحاجج الفيلسوف ألكسندر كوجيف على
وجاهة هذا الطرح الهيغلي، من خلال تأكيده أن هذه العلاقة الصراعية هي ما
حكم تاريخ الإنسانية، قائلا: " إن تاريخ الإنسانية هو تاريخ تفاعل بين
مبدأي السيادة والعبودية"، بل ويضيف "إن الوجود البشري لا يتكون
إلا من خلال الصراع الذي يؤدي إلى العلاقة بين السيد والعبد".
وبالتالي فإن
المجتمعات البشرية لم تتقدم إلا من خلال الصراع الذي كان بين أفرادها، وهو صراع من
أجل نيل الاعتراف، لذلك كان الأصل في الوجود الانساني الصراع لنيل الاعتراف. غير أن هذا الصراع يظل إنسانيا لا وحشيا، فإذا
كان الصراع الوحشي ينتهي بموت أحد طرفيه مقتولا، فإن الصراع الانساني يتوقف
باستسلام أحد طرفيه، وهذا التفاوت هو ما يتولد عنه مبدأي العبودية والسيادة. حيث ينتصر أحد طرفيه وينهزم الطرف الآخر،
ويتحقق الانهزام بإعلان الطرف المستسلم الاعتراف للمنتصر بالسيادة، والرضا بمنزلة
العبد، مقابل البقاء حيا، وبذلك ينشأ مفهوما العبد والسيد.
فما السيد ؟ وما العبد ؟
ü
الأول السيد: إذ صفته الاستعداد للموت ولركوب المخاطرة إلى أقصى
حدودها، دونما رهبة من الموت، وبذل النفس ومجابهة المصاعب، وهو بذلك محارب لا
يعمل.
ü الثاني العبد: وهو الذي رضي بحفظ حياته البهيمية، واعترف بالآخر سيدا، مفضلا للحياة على الموت وهو بذلك قايض حياته بحريته. فاعترف بالسيادة للآخر ورضي بعبوديته إيثارا للسلامة على المهانة.
نستنتج
مما سبق أن السيادة مبدأ مكتسب منتزع، وأن العبودية حالة طارئة ومؤقتة، فهي إذن
ليست صفات طبيعية، بل مآل ومصير، بإمكان الإنسان تحصيله أو تفاديه، لأن الأصل في
الذوات البشرية هو النزوع إلى الحرية والهيمنة. ولذلك فإن تاريخ الانسانية بالحقيقة هو تاريخ
عبد أفلح في تحرير نفسه من رهاب الموت وجبن المخاطرة، غير أن هذه الحركة المستمرة
طلبا للحرية بما هي الرغبة في نيل الاعتراف.
3-مطلب المناقشة:
ü
ابراز قيمة الاجابة المقترحة
يستمد التصور السابق للعلاقة مع الغير،
باعتبارها علاقة صراع وهيمنة، قيمته من اعتباره تصورا تاريخيا
وواقعيا، فتاريخيا العلاقة بين الأفراد والمجتمعات حكمها مبدأ الصراع، ولا
أدل على ذلك من تاريخ الحروب، أما واقعيا فإننا نلمس أن الهيمنة على الغير مبدأ
محرك لأغلب سلوكات البشر، فيها تحكم مستمر بدون انقطاع، بداية من تحكم الأباء في
الأبناء، إنتهاء بتحكم الدولة في الأفراد، دونما الغفلة عن نزعة استغلال البعض
للبعض والتي تفسد العلاقات حتى ولو كانت من باب الحب والصداقة.
ü إبراز حدود الأطروحة والانفتاح على مواقف أخرى:
غير أن هذا التصور
لا يسمو إلى الحقيقة أساسية وهي أن العلاقات الإجتماعية مهما كانت
مطبوعة بنسبة معقولة من الصراع والهيمنة الخفية أو البينة، فإنها من جهة أخرى تحمل
في طياتها أبعادا مختلفة، تقوم على الحب والصداقة والإنسانية، كما مثلما أن الأمم
لم تتقدم بالصراعات فقط، بل وأيضا بالاتحاد والسلم، ومثال الإتحاد الأوروبي ليس ببعيد.
استحضار مقاربات أخرى تؤكد على أن الصداقة أساس العلاقة مع الغير
ومن جهة أخرى فإن إنسانية الإنسان لا تتقوم فقط بالسيادة والهيمنة، بل
بالرحمة والكرامة، وهكذا فإن العلاقة مع الغير، تتخذ أشكالا عدة وما علاقة الصراع
إلا أحدها، ورغم وجودها الفعلي، فهي تظل علاقة سلبية، لأن ما ينتج عنها من
"إيجابيات"، يمكن تحقيقه بغيرها، ومن ذلك علاقة الصداقة.
ü استحضار مقاربات أخرى تؤكد على أن الصداقة أساس العلاقة مع الغير
إن العلاقة مع الغير التي أساسها الصداقة باعتبارها علاقة
إيجابية، أشد أهمية من علاقة الصراع، ذلك أن "الصداقة فضيلة" كما
يقول أرسطو، بل وضرورية، فهي حاجة فطرية وطبيعية للإنسان في جميع مراحله العمرية
طفلا وكهلا وشيخا، وفي جميع حالاته الإجتماعية فقيرا وغنيا، وأحواله الجسدية ضعيفا
وقويا، بل إن وجود الصداقة بمعناها الأسمى، أي الصداقة القائمة على محبة الخير
يمكن أن يكون بديلا عن وجود العدل نفسه.
يقول أرسطو "متى أحب الناس
بعضهم بعضا (صداقة محبة)، لم يعد هناك حاجة للعدل"، ومعنى ذلك أن العدل
نفسه لا يعوض الصداقة والعكس صحيح. فإذا سادت الصداقة بين الناس، تحققت المساواة،
وساد النظام، واختفى الظلم، دونما ولم تعد هناك حاجة للقوانين.
الصداقة إذن من منظور أرسطو علاقة إيجابية مع الغير، وضرورة اجتماعية
بين الناس. فهي الصورة المثلى للحياة المشتركة بين الذوات، بما هي حياة أخلاقية
يحكمها بمبدأ حفظ كرامة الذات الإنسانية.
وعلى نفس المنوال أكد ذلك كانط من بعده، في قاعدته الأخلاقية القائلة: "تصرف على نحو تعامل فيه الانسانية، في شخصك كما في شخص غيرك، دائما وأبدا، باعتبارها غاية وليست مجرد وسيلة"، تأكيدا للقيمة المطلقة للإنسان. وهذا يدل على أهمية الصداقة في العلاقات الإنسانية، فأنظر مثلا كيف أن المرء إذا أراد أن يتخذ عدة أعداء في ساعة واحدة قدر على ذلك. وإذا قصد اتخاذ صديق ومصافاة خليل، لم يستطع إلا بزمان واجتهاد وطاعة ومشقة.
4-مطلب التركيب:
توجيهات منهجية:
(المطلوب خلاصة لنتائج التحليل والمناقشة، وأبداء رأي شخص مبني )
قصارى القول، إن مشكلة العلاقة مع
الغير تأرجحت وفقا لما سبق لنا ذكره أعلاه، بين تصورين: تصور يؤسسها على الصراع
والهيمنة (هيغل وكوجيف) وتصور يجعل الصداقة والاحترام (أرسطو وكانط)
ركيزتها.
ورغم التباعد البين بين الموقفين والتعارض الواضح بين أساسهما، فإن ما يؤكدانه،
إنما هو أن العلاقة مع الغير ليست بالأمر العارض ولا بالشأن الهين. بل إن العلاقة
مع الغير مسألة خطيرة؛ لأنها تنعكس على وجود الذات وعلى الحياة الإجتماعية. وعلى
الوضع البشري ككل فالعلاقة بين الذوات المتميزة بالاستقلال، ليست استغلالا ولا
استعمالا، بل اعتراف متبادل يؤسس لوحدتها، ويبني سعادتها، التي تظل غير مكتملة
بدون الغير.
لذلك أخلص للقول إن العلاقة مع الغير أساسها الصداقة، لا صداقة منفعة ومتعة
بين الأفراد، بل صداقة احترام ومحبة للخير، إتجاه الإنسانية جمعاء، يتم فيها
الاعتراف المتبادل بقيمتنا المشتركة، وبوجوه تميزنا، أي صداقة إنصاف في مودة، وهي
علاقة إيثارية نحب فيها الخير للإنسانية بقدر عرفاننا بفضلها علينا، وفي ذلك نكران
للذات وعرفان للغير، مؤسس لا محالة للحياة الطيبة.